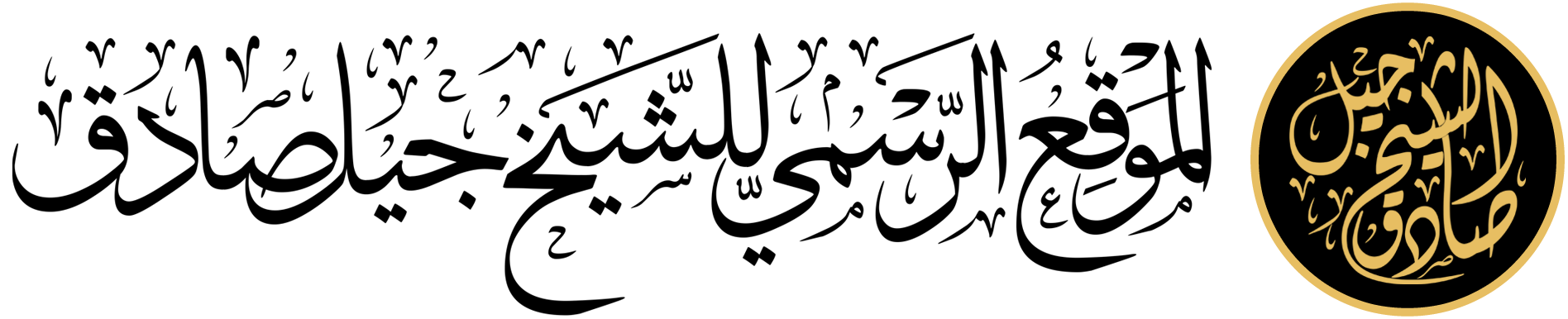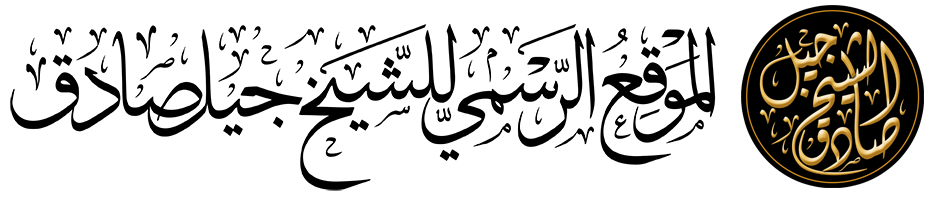المقالة الخامسة : في تحريمه التوسل بالأنبياء والصالحين والتبرك بهم وءاثارهم
المقالة الخامسة : في تحريمه التوسل بالأنبياء والصالحين والتبرك بهم وءاثارهم
ومن أشهر ما صحّ عن ابن تيمية بنقل العلماء المعاصرين له وغيرهم ممن جاءوا بعدهم، تحريمه التوسل بالأنبياء والصالحين بعد موتهم وفي حياتهم في غير حضورهم والتبرك بهم وبآثارهم، وتحريمه زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام للتبرك، فهو كما تبيّن يتقوّل على الأئمة وذلك عادة له، فقد خالف الإمام أحمد والإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي، وهو كما قال فيه الحافظ السبكي: ولم يسبق ابن تيمية في إنكاره التوسل أحد من السلف ولا من الخلف، بل قال قولًا لم يقله عالم قط قبله، قال في شفاء السقام [1] ما نصه: “اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر أحد ذلك من أهل الاديان ولا سمع به في زمن من الازمان حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار” اهـ.
وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي المتوفى في القرن العاشر الهجري في مبحث سن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم [2] ما نصه: “ولا يغترّ بإنكار ابن تيمية لسن زيارته صلى الله عليه وسلم فإنه عبد أضلّه الله كما قاله العز بن جماعة، وأطال في الرد عليه التقي السبكي في تصنيف مستقل، ووقوعه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعجب فإنه وقع في حق الله، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا، فنسب إليه العظائم كقوله إن لله تعالى جهة ويدًا ورجلًا وعينًا [3] وغير ذلك من القبائح الشنيعة، ولقد كفره كثير من العلماء، عامله الله بعدله وخذل متبعيه الذين نصروا ما افتراه على الشريعة الغراء” اهـ.
وهو أي ابن تيمية يحرّم التوسل والاستغاثة برسول الله وغيره من الأنبياء والأولياء وأخذ منه ذلك أتباع محمد بن عبد الوهاب وزادوا التكفير بما فهموه من تعبيراته، والذي أدى بهم إلى ذلك هو جهلهم بمعنى العبادة الواردة في نحو قوله تعالى: {إياكَ نعبُدُ وإياكَ نستعين} [سورة الفاتحة/5] وقوله تعالى حكاية عن المشركين: {ما نعبُدُهُم إلا ليُقَرِّبونا إلى اللهِ زُلفى} الآية [سورة الزمر/3]. نقول لهم: العبادة في لغة العرب هي ما عرّفها به اللغويون، فقد عرفها الإمام اللغوي الشهير الزجاج بقوله: “العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع”، وقال الإمام اللغوي أبو القاسم الراغب الاصبهاني في مفردات القرءان: “العبادة غاية التذلل”، وقال الإمام الحافظ الفقيه اللغوي المفسر علي بن عبد الكافي السبكي [4] في تفسيره لقوله تعالى: {إياكَ نعبد} [سورة الفاتحة/5] “أي نخصك بالعبادة التي هي أقصى غاية الخشوع والخضوع”، وقال النحوي اللغوي المفسر أبو حيان الاندلسي في تفسيره عند قول الله تعالى: {إياك نعبد} [سورة الفاتحة/5] العبادة عند جمهور اللغويين التذلل، وقال ابن السّكّيت: التجريد، وقال الفيومي اللغوي في المصباح المنير: عبدت الله أعبده عبادة، وهي الانقياد والخضوع، والفاعل عابد، والجمع عبّاد، وعبدة مثل كافر وكفّار وكفرة، ثم استعمل فيمن اتخذ إلهًا غير الله وتقرّب إليه فقال: عابد الوثن والشمس وغير ذلك اهـ.
وكذلك جهل هؤلاء بمعنى الدعاء الوارد في القرءان في مواضع كقوله تعالى: {يَدعوا لَمَن ضَرُّهُ أقربُ مِن نفعِهِ} [سورة الحج/13] وقوله تعالى: {وَمَنْ أضلُّ مِمَّن يدعوا مِن دونِ اللهِ مَن لا يستجيبُ لهُ} [سورة الأحقاف/5]، طنوا أن هذا الدعاء هو مجرد النداء، ولم يعلموا أن معناه العبادة التي هي غاية التذلل، فإن المفسرين قد أطبقوا على أن ذلك الدعاء هو عبادتهم لغير الله على هذا الوجه، ولم يفسره أحد من اللغويين والمفسرين بالنداء، لذلك صار هؤلاء يكفرون من يقول: يا رسول الله، أو: يا أبا بكر، أو: يا علي، أو: يا جيلاني، أو نحو ها في غير حالة حضورهم في حياتهم وبعد وفاتهم، ظنًا منهم أن هذا لانداء هو عبادة لغير الله، هيهات هيهات، ألم يعلم هؤلاء أن القراءن والحديث لا يجوز تفسيرهما بما لا يوافق اللغة، وماذا يقول هؤلاء فيما رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر أنه خدرت [5] رجله فقيل له: اذكر أحب الناس إليك، فقال: يا محمد، فكأنما نُشِطت مِن عِقال [6]، هل يكفّرونه لهذا النداء أم ماذا يفعلون؟ وماذا يقولون في إيراد البخاري لهذا هل يحكمون عليه أنه وضع في كتابه الشرك ليعمل به؟
ومن شبه هؤلاء إيرادهم لحديث البخاري وغيره: “الدعاء هو العبادة” –رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان-، يريدون بذلك أن يوهموا الناس أن التوسل بالأنبياء والأولياء بعد موتهم أو في غير حضرتهم ولو كانوا أحياءً شرك عبادة لغير الله. فالجواب: أن معنى الحديث أن الدعاء الذي هو الرغبة إلى الله كما عرّف بذلك علماء اللغة الدعاءَ من أعظم أنواع العبادة، بمعنى ما يُتقرب به إلى الله، لأن الصلاة التي هي أفضل ما يتقرب به إلى الله بعد الإيمان مشتملة على الدعاء، فهذا من العبادة التي هي أحد إطلاقي لفظ العبادة في عرف أهل الشرع كإطلاقها على انتظار الفرج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “انتظار الفرج عبادة” –رواه ابن حبان-، وهذا الإطلاق راجع إلى تعريف العبادة العام الذي هو غاية التذلل لأن العبد لما يدعو الله تعالى راغبًا إليه حيث إنه خالق المنفعة والمضرة، فقد تذلل له غاية التذلل. وبالله التوفيق والعصمة.
ثم من المعلوم أن العبادة تطلق من باب الحقيقة الشرعية المتعارفة عند حملة الشريعة على فعل ما يتقرب به إلى الله، وقد وردت فيما صح عن رسول الله بمعنى الحسنة كقوله صلى الله عليه وسلم: “انتظار الفرج عبادة” أي حسنة يتقرب بها إلى الله، وبهذا المعنى الصدقة والصيام وعمل المعروف والإحسان إلى الناس، وهذا شائع كثيرًا.
قال الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل ما نصه [7]:
وقد بلغ بالناظم وشيخه الغلو في هذا الصدد إلى حد تحريم شد الرحال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدّ السفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة، فأصدر الشاميون فتيا في ابن تيمية وكتب عليها البرهان بن الفركاح الفزاري نحو أربعين سطرًا بأشياء إلى أن قال بتكفيره ووافقه على ذلك الشهاب بن جهبل، وكتب تحت خطه كذلك المالكي، ثم عرضت الفتيا على قاضي قضاة الشافعية بمصر البدر بن جماعة فكتب على ظاهر الفتوى الحمد لله هذا المنقول باطنها جواب عن السؤال عن قوله: إن زيارة الانبياء والصالحين بدعة وما ذكره من نحو ذلك، وإنه لا يرخص بالسفر لزيارة الأنبياء باطل مردود عليه، وقد نقل جماعة من العلماء أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وسنة مجمع عليها، وهذا المفتي المذكور –يعني ابن تيمية- ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند الأئمة والعلماء، ويمنع من الفتاوى الغريبة، ويحبس إذا لم يمتنع من ذلك ويشهر أمره ليتحفظ الناس من الاقتداء به. وكتبه محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الشافعي اهـ.
ثم قال ما نصه [8]: والأحاديث في زيارته صلى الله عليه وسلم في غاية من الكثرة وقد جمع طرقها الحافظ صلاح الدين العلائي في جزء، قال علي القاري في شرحه الشفاء: “وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرّم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أفرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر ولعل الثاني أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرًا لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه…” [9] اهـ.
ثم قال: “فسعيه في منع الناس من زيارته صلى الله عليه وسلم يدل على ضغينة كامنة فيه نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة والتوسل في المسلمين الذين يعتقدون في حقه عليه السلام أنه عبْده ورسوله وينطقون بذلك في صلواتهم نحو عشرين مرة في كل يوم على أقل تقدير أدامة لذكرى ذلك. ولم يزل أهل العلم ينهون العوام عن البدع في كل شئونهم ويرشدونهم إلى السنّة في الزيارة وغيرها إذا صدرت منهم بدعة في شيء، ولم يعدُّوهم في يوم من الأيام مشركين بسبب الزيارة أو التوسل، كيف وقد أنقذهم الله من الشرك وأدخل في قلوبهم الإيمان، وأول من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين ودماءهم لحاجة في النفس، ولم يخف ابن تيمية من الله في رواية عدّ السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة عن الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، وحاشاه عن ذلك، راجع كتاب التذكرة له تجد فيه مبلغ عنايته بزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتوسل له كما هو مذهب الحنابلة، وإنما قوله بذلك في السفر إلى المشاهد المعروفة في العراق لما قارن ذلك من البدع في عهده وفي نظره. وإليك نص عبارته في التذكرة المحفوطة بظاهرية دمشق تحت رقم [87] في الفقه الحنبلي: “فصل: ويستحب له قدم مدينة الرسول صلوات الله عليه، فيأتي مسجده فيقول عند دخوله: بسم الله اللهم صل على محمد وءال محمد وافتح لي أبواب رحمتك وكفّ عني أبواب عذابك، الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشهد وجعلنا لذلك أهلًا، الحمد لله رب العالمين. إلى أن قال: واجعل القبر تلقاء وجهك، وقم مما يلي المنبر وقل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم صلّ على محمد وعلى ءال محمد إلى ءاخر ما تقوله في التشهد الأخير، ثم تقول: اللهم أعط محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته اللهم صلّ على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد كما بلّغ رسالاتك وتلا ءاياتك وصدع بأمرك حتى أتاه اليقين، اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: {ولوْ أنَّهُمْ إذ ظَّلموا أنفُسَهُمْ جاءُوكَ فاستَغْفَروا اللهَ واستغفرَ لهُمُ الرسولُ لَوَجدوا اللهَ تَوَّابًا رحيمًا} [سورة النساء/64] وإني قد أتيت مبيك تائبًا مستغفرًا فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر ذنوبي”. إلى أن قال: “وإن أحببت تمسح بالمنبر وبالحنّانة وهو الجذع الذي يخطب عليه صلى الله عليه وسلم فلما اعتزل عنه حنّ إليه كحنين الناقة” اهـ.
ففي هذا التوسل الذي أورده ابن عقيل دليل على أن عمل المسلمين كان على التوسل بالنبي بعد موته من غير نكير، إنما هذا التحريم من ابن تيمية ومن أتباعه فيما بعده، وابن عقيل توفي قبل ابن تيمية [10] وهو من أساطين الحنابلة من أهل التخريج.
وليكن منك على ذكر حديث: “الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون” فقد رواه أبو يعلى الموصلي [11] والبزار [12] في مسنديهما، وأورده البيهقي في الجزء الذي ألفه في حياة الانبياء وهو مطبوع وأورده أيضًا الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وسيأتي مفصلًا.
وأما أدلة أهل الحق على جواز التوسل بالرسول في حياته وبعد مماته فمن ذلك ما أخرجه الطبراني في معجميه الكبير والصغير [13] عن عثمان بن حنيف أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، وقال: ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، ثم رح حتى أروح معك. فانطلق الرجل ففعل ما قال، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه على طِنْفسته، فقال: ما حاجتك؟ فذكر له حاجته، فقضى له حاجته وقال: ما ذكرتُ حاجتك حتى كانت هذه الساعة، ثم خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال: جزاك الله خيرًا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ حتى كلمته فيّ، فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال: “إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك”، قال: يا رسول الله إنه شقّ عليّ ذهاب بصري وإنه ليس لي قائد، فقال له: “ائت الميضأة فتوضأ وصلّ ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك…” إلى ءاخر الدعاء. قال عثمان بن حنيف: ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضرٌّ قطّ.
قال الطبراني في معجميه: والحديث صحيح اهـ. ولفظ الحديث عند علماء الحديث يطلق على ما يرفع إلى النبي وما يوقف على الصحابي كما هو مقرر في كتب الاصطلاح، وقد أطلق الإمام أحمد لفظ الحديث على أثر لعمر في الجُبن الذي يأتي به المجوس، وكان من عاداتهم أن يستعملوا في الجبن أنفحة الميتة.
فهذا الحديث حجة في جواز التوسل بالرسول في حياته وبعد مماته، في حضرته وفي غير حضرته، وليس الأمر كما يقول ابن تيمية فإنه قال: لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، وبما أن الألباني يتبعه فقد طعن في القَدْر الموقوف من الحديث بقوله: إن الموقوف منكر، ومنشأ هذا الخبط للألباني هو مجاوزته حدّه حيث لم يقف عند نصوص علماء الحديث أنّ من لم يبلغ مرتبة الحافظ ليس له التصحيح والتضعيف، وكذا الحكم بالوضع. وروى هذا الحديث أيضًا الحافظ السبكي والبيهقي.
ولنزد على ما مضى أن توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمه رسول الله لم يكن بحضور الرسول، بل ذهب إلى الميضأة فتوضأ وصلى ودعا باللفظ الذي علمه رسول الله، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يفارق مجلسه لقول راوي الحديث عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر.
ومما يدل أيضًا على أن توسل هذا الاعمى كان في غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال يا محمد في غير حضرته، أنه قد ثبت النهي عن نداء الرسول باسمه في وجهه لقوله تعالى: {لا تجعلوا دُعاءَ الرسولِ بينَكُم كدُعاءِ بعضِكُم بعضًا} [سورة النور/63] الآية.
ومن ذلك حديث: “من قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعةً، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك” –رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي- ولا التفات بعد تحسين الحافظين له إلى قول الألباني بتضعيفه، لأن الالباني ليس من أهل مرتبة الحفظ بل بعيد منها بُعد الأرض من السماء، وقد اعترف هو في بعض ما كتب بعدم بلوغه مرتبة الحفظ. والشرط في تصحيح الحديث أو تضعيفه وكذا الحكم بالوضع أن لا يؤخذ إلا من كلام حافظ كما نص عليه السيوطي في تدريب الراوي، وهل تجرّؤ الألباني على التصحيح والتضعيف والحكم بالوضع عن عدم اطلاع على كلام أهل الحديث في المصطلح؟ أن يكون اطلع لكن الهوى جرّه وحبّ الظهور ودعوى ما ليس له ظنًّا منه أن الناس يروج عليهم كلامه إذا صحح أو حسّن أو ضعّف؟.
ولنذكر هنا نص الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار لما في ذلك من إزالة لبس توهمه بعض الناس من عدم الفرق بين الحديثين الحديث الفعلي والحديث القولي، لأن الحديث الفعلي هو الضعيف وأما الحديث القولي فإنه ثابت، قال: قوله –يعني النووي- وروينا في كتاب ابن السني عن بلال، وبالسند الماضي إلى أبي بكر بن السني مرارًا، ثنا عبد الله بن محمد البغوي ثنا الحسن بن عرفة ثنا علي بن ثابت الجزري عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلّم قال: “كان النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: “بسم الله ءامنت بالله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وتدخلني الجنة”، هذا حديث واهٍ جدًا أخرجه الدارقطني في الأفراد من هذا الوجه، وقال: تفرد الوازع به، وقد نقل المصنف أنه متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث، قلت: والقول فيه أشد من ذلك، قال يحيى بن معين والنسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم وجماعة: متروك، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها غير محفوظة. قلت: وقد اضطرب في هذا الحديث، وأخرجه أبو نعيم في اليوم والليلة من وجه ءاخر عنه فقال: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن بلال ولم يُتابع عليه أيضًا.
قوله: -يعني النووي- وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم، وعطية أيضًا ضعيف، قلت: ضعفه إنما جاء من قبل التشيع ومن قبل التدليس، وهو في نفسه صدوق. وقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأخرج له أبو داود عدة أحاديث ساكتًا عليه، وحسّن له الترمذي عدة أحاديث بعضها من أفراده فلا تظن أنه مثل الوازع.
قرأت على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقية بها عن أبي الفضل بن أبي طاهر قال: أنا إسماعيل بن ظفر أنا محمد بن أبي زيد أنا محمود بن إسماعيل أنا أبو الحسين بن فاذشاه أنا الطبراني في كتاب الدعاء ثنا بشر بن موسى ثنا عبد الله بن صالح هو العجلي ثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم: “إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكّل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له، وأقبل [14] الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته”، هذا حديث حسن أخرجه أحمد عن زيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق، واخرجه ابن ماجه عن محمد بن يزيد عن إبراهيم التستري عن الفضل بن موفق، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من رواية محمد بن فضيل بن غزوان ومن رواية أبي خالد الأحمر، وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني من رواية أبي نعيم الكوفي، كلهم عن فضيل بن مرزوق. وقد رويناه في كتاب الصلاة لأبي نعيم وقال في روايته عن فضيل عن عطية: قال حدثني أبو سعيد فذكره لكن لم يرفعه، وقد أُمن بذلك تدليس عطية.
وعجبت للشيخ كيف اقتصر على سوق رواية بلال دون أبي سعيد وعلى عزو رواية أبي سعيد لابن السني دون ابن ماجه وغيره. والله الموفق [15] اهـ. ومحمل الشاهد في هذا “أسألك بحق السائلين”، والسائلين جمع يشمل الأموات والاحياء ومن كان حاضرًا، ومن كان غائبًا، فظهر بطلان تلبيس ابن تيمية.
ففي هذا الحديث دليل على جواز التوسل بالأحياء والأموات لأن لفظ السائلين يشملهما، وجواز التوسل بالعمل الصالح وهو ممشى الرجل إلى المسجد لوجه الله، فالشرع لم يفرق بين التوسل بالذوات الفاضلة وبين التوسل بالعمل الصالح، بل لقائل أن يقول: كيف لا يجوز التوسل بذات رسول الله الذي هو أشرف خلق الله ويجوز التوسل بصلاة العبد وصيامه وصدقته، وكلا الأمرين خلق الله، الذوات الفاضلة خلق الله، والاعمال الصالحة التي يعملها العباد خلق الله، فأي معنى للتفريق؟
قال التقي السبكي في شفاء السقام [16] ما نصه: وأقول إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال: قبل خلقه، وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا، وبعد موته في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القيامة والجنة. وهو على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يتوسل به بمعنى أن طالب الحاجة يسأل الله تعالى به أو بجاهه أو لبركته فيجوز ذلك في الأحوال الثلاثة، وقد ورد في كل منها خبر صحيح، أما الحالة الأولى قبل خلقه فيدل على ذلك ءاثار عن الأنبياء الماضين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته وهو ما رواه الحاكم أبو عبد الله بن البَيّع في المستدرك على الصحيحين أو أحدهما. قال ثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور المعدل، ثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري، ثنا إسماعيل بن مسلمة أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لما اعترف ءادم عليه السلام بالخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا ءادم، وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه، قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا: “لا إله إلا الله محمد رسول الله” فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا ءادم، إنه لأحب الخلق إليّ، إذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك”. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب. ورواه البيهقي أيضًا في دلائل النبوة وقال تفرد به عبد الرحمن وذكره الطبراني وزاد فيه: “وهو ءاخر الأنبياء من ذريتك”.
وذكر الحاكم مع هذا الحديث أيضًا عن علي بن حمشاذ العدل، ثنا هارون بن العباس الهاشمي، ثنا جندل بن والق، ثنا عمرو بن أوس الأنصاري، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس قال: “أوحى الله إلى عيسى عليه السلام، يا عيسى ءامن بمحمد وامر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا محمد ما خلقت ءادم، ولولاه ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه “لا إله إلا الله فسكن”، قال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولن يخرجاه. انتهى ما قاله الحاكم.
والحديث المذكور لم يقف عليه ابن تيمية بهذا الإسناد ولا بلغه أن الحاكم صححه فإنه قال: -أعني ابن تيمية-: أما ما ذكره في قصة ءادم من توسله فليس له أصل ولا نقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد يصلح للاعتماد عليه ولا للاعتبار ولا للاستشهاد، ثم ادعى ابن تيمية أنه كذب وأطال الكلام في ذلك جدًا بما لا حاصل تحته بالوهم والتخرص ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال ذلك أو لتعرض للجواب عنه، وكأني به إن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث، ونحن نقول: قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم، وأيضًا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يبلغ في الضعف إلى الحد الذي ادعاه، وكيف يحل لمسلم أن يتجاسر على منع هذا الامر العظيم الذي لا يرده عقل ولا شرع وقد ورد فيه هذا الحديث، وسنزيد هذا المعنى صحة وتثبيتًا بعد استيفاء الأقسام اهـ.
والبيهقي التزم في كتابه أن لا يذكر حديثًا يعلمه موضوعًا، فالعجب من جرأة ابن تيمية على إطلاق أن أحدًا ممن يعتدُّ به من المحدثين لم يذكره ومن قول الذهبي في هذا الحديث أظنه موضوعًا، وليس هناك أدنى متمسك، وليس فيه ركاكة من حيث المعنى، فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليس ممن اتهم بالكذب، فما الداعي للذهبي إلى أن يقول هذه المقالة، اللهم إلا أن يكون من الذين هم قلوبهم منحرفة عن التوسل بالنبي.
ثم قال: وأما ما ورد من توسل نوح وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء فذكره المفسرون واكتفينا عنه بهذا الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له ولا فرق في هذا المعنى بين أن يعبر عنه بلفظ التوسل أو الاستعانة أو التشفع أو التجوه والداعي بالدعاء المذكور وما في معناه متوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه جعله وسيلة لإجابة الله دعاءه ومستغيث به -والمعنى أنه استغاث الله به على ما يقصده، فالباء ها هنا للسببية وقد ترد للتعدية كما يقول: من استغاث بك فأغثه- ومستشفع به ومتوجه فإن التجوه والتوجه راجعان إلى معنى واحد. اهـ كلام السبكي.
وأكثر ما يوردونه من الشبه لتحريم التوسل وتحريم زيارة قبر الرسول أمور ليس فيها ما يدّعون، كحديث عبد الله بن عباس مرفوعًا وفيه: “إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله”، ويجاب عن ذلك بأن الحديث ليس فيه لا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله، وإنما مراد النبي بذلك أن الأولى بأن يُسأل ويُستعان به هو الله، فكيف يفترون على رسول الله وابن عباس لإثبات دعواهم تكفير المتوسل والمستغيث برسول الله، وإنما هذا كقول رسول الله في حديث ابن حبان: “لا تصاحب إلا مؤمنًا ولا يأكل طعامك إلا تقي”، فهل في هذا الحديث أن مصاحبة غير المسلم حرام؟! وهل يفهم منه أن إطعام غير التقي حرام؟! وقد رخَّ الله في كتابه بإطعام الأسير الكافر، بل مدح ذلك بقوله: {ويُطعِمونَ الطعامَ على حُبِّهِ مِسكينًا ويتيمًا وأسيرًا} [سورة الإنسان/8].
ومن شبههم حديث عمر أنه استسقى بالعباس، ادعوا أن عمر إنما توسل بالعباس لأن الرسول كان قد توفي. والجواب أن يقال: هل قال لكم عمر أو العباس إن هذا التوسل لأن الرسول كان قد توفي، لا قال عمر ذلك ولا أشار إليه، ولا قال العباس ذلك ولا أشاؤ إليه، إنما هو من افتراءاتكم عليهما لتؤيدوا به هواكم تكفير المتوسل بالنبي.
وقد يذكرون حديثًا متفقًا على ضعفه وهو من شبههم أيضًا أن أبا بكر قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال رسول الله: إنه لا يستغاث بي، إنما يُستغاث بالله. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: هذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وهو معارض للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا وفيه أن الشمس تدنو من رءوس الناس يوم القيامة حتى يبغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم، فكيف يتعلقون بحديث غير ثابت وقد عارضه الحديث الصحيح.
وفي كتاب كشاف القناع [17] ما نصه: وقال السامرّي وصاحب التلخيص: لا بأس بالتوسل للاستسقاء بالشيوخ والعلماء المتقين، وقال في المذهَّب: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح، وقيل يستحب.
وقال أحمد في منسكه الذي كتبه للمرّوذي: إنه يتوسَّل بالنبي في دعائه –يعني أن المستسقي يسن له في استسقائه أن يتوسل بالنبي-، وجزم به في المستوعب وغيره، ثم قال: قال إبراهيم الحربي: الدعاء عند قبر معروف الكرخي الترياق المجرب اهـ. وإبراهيم الحربي من معاصري أحمد بن حنبل، توفي بعده بنحو أربعين سنة، وكان من جلّة المحدثين الثقاة بل ومن المجتهدين، وقد ذكر في ترجمته أنه كان يشبه بأحمد بن حنبل، فقول ابن تيمية إن ذلك بدعة قبيحة باتفاق الأئمة كلام مردود، يشهد برده نص كلام الإمام أحمد وكلام إبراهيم الحربي الذي هو من جلة الأئمة من السلف فأين الاتفاق الذي يدّعيه ابن تيمية؟.
قال الشيخ علاء الدين علي المرداوي الحنبلي وهو من مشاهير علماء الحنابلة في كتابه الانصاف [18] ما نصه: “ومنها يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب، وقيل: يستحب، قال الإمام أحمد للمروذي: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وجزم به في المستوعب وغيره، وجعله الشيخ تقي الدين كمسألة اليمين به، قال: والتوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحوه مما هو من فعله أو أفعال العباد المأمور بها في حقه مشروع إجماعًا” اهـ.
قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء [19] ما نصه: وكان صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله، وقيل أبو الحارث القرشي الزهري الفقيه العابد، وأبوه سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال أحمد: هو يستسقى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره، وقال مرة: هو ثقة من خيار عباد الله الصالحين. قال الواقدي وغيره: مات سنة 132 عن اثنتين وسبعين سنة روى له الجماعة [20] اهـ.
ونقل ذلك أيضًا السيوطي في طبقات الحافظ فقال: وذكر –أي صفوان بن سليم- عند أحمد فقال [21]: هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. مات سنة أربع وعشرين ومائة اهـ.
أما ما يذكر عن أبي حنيفة أنه كره أن يقال أسألك بحق أنبيائك، فليس معناه تحريم التوسل على الإطلاق في جميع صوره وألفاظه، إنما كره أبو حنيفة هذه بحق أنبيائك، كما أهل مذهبه، لأنها توهم أن للعباد حقًا على الله لازمًا، وأهل مذهبه أدرى بكلامه، فالحنفية ما زالوا يتوسلون بأنبياء الله ويرون ذلك قربة إلى الله. والظاهر أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه ما بلغه هذا الحديث الذي فيه التوسل بلفظ بحق، ولو بلغه لم يقل ذلك، فالعمل على جوازه بلا كراهة، لأن الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الهدى لا يقدمون كلامهم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمل أهل مذهبه على استعمال هذا اللفظ في التوسل، ما رأينا أحدًا منهم يستنكر استعمال لفظ بحق في التوسل، والذي يعتقده كل الائمة هذه القاعدة: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
وأما ما يذكر أنه قال: لا يُدعى الله بغيره، فهو بعيد من الصحة، كيف وقد ثبت في الصحيح أن ثلاثة أواهم المطر إلى الغار، فانطبقت صخرة نزلت من أعلى الجبل على فم الغار، فدعا كل من الثلاثة الله بصالح عمله، وهذا أخرجه البخاري وغيره، فكيف يُلتفت إلى هذا النقل عن أبي حنيفة المصادم للصحيح، فقد ذكر الألباني في بعض المجالس في الكلام على التوسل هذه العبارة: أما التوسل فقد كفانا أبو حنيفة المؤنة، يريد بذلك أن أبا حنيفة يحرم التوسل مطلقًا كما يحرمونه، فليثبت هؤلاء إن استطاعوا أن أبا حنيفة قال يحرم التوسل بالنبي بعد موته أو في حياته في غير حضرته كما يدعي أتباع ابن تيمية في قوله: لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر.
قال ابن عابدين في حاشيته [22]: ذكر العلامة المناوي في حديث: “اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة” عن العز بن عبد السلام أنه ينبغي كونه مقصورًا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقسم على الله بغيره، وأن يكون من خصائصه، قال: قال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله. اهـ.
مسئلة: إن قال مانعو التوسل بالأموات والحي الغائب لا معنى للتوسل بهم بأن يقال: يا رسول الله أغثني أو: أتوجه بك إلى الله ليقضي لي حاجتي لأنه لا يسمع، وأما الحي الحاضر فيسمع. قلنا: لا مانع شرعًا ولا عقلًا من أن يسمع النبي أو الولي كلام من يتوسل به وهو في القبر، أما النبي فلأنه حي أحياه الله بعد موته كما ثبت من حديث أنس عن رسول الله أنه قال: “الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون” صححه البيهقي في جزء حياة الأنبياء، وأورده الحافظ ابن حجر على أنه ثابت في فتح الباري، وذلك لما التزمه أن ما يذكره من الاحاديث شرحًا أو تتمة لحديث في متن البخاري فهو صحيح أو حسن ذكر ذلك في مقدمة الفتح. ولأنه ثبت حديث: “ما من رجل مسلم يمرّ بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام”.
قال المناوي في شرح الجامع الصغير ما نصه: حديث: “ما من عبد يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام” رواه ابن عساكر في التاريخ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأفاد الحافظ العراقي أن ابن عبد البر خرّجه في التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، وممن صححه عبد الحق بلفظ: “ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام” اهـ. قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، أقول: بل قال في تهذيب التهذيب عن عبد الرحمن بن زيد العدوي قال ابن عدي له أحاديث حسان وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو ممن يُكتب حديثه.
وعبارة الحافظ في شرح البخاري في باب أحاديث الأنبياء ما نصه: “… وقد جمع البيهقي كتابًا لطيفًا في “حياة الأنبياء في قبورهم”، أورد فيه حديث أنس: “الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون”، أخرجه من طريق يحيى بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح عن المستلن بن سعيد، وقد وثقه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسود وهو ابن أبي زياد البصري، وقد وثقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه، وأخرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه وأخرجه البزار لكن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم، والصواب الحجاج الأسود كما وقع التصريح به في رواية البيهقي وصححه البيهقي” اهـ.
ثم قال: “… وشاهد الحديث الأول ما ثبت في صحيح مسلم من رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رفعه: “مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره”، وأخرجه أيضًا من وجه ءاخر عن أنس. فإن قيل هذا خاص بموسى، قلنا: قد وجدنا له شاهدًا من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: “لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي” الحديث، وفيه: “وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه…” وفيه: “وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، فحانت الصلاة فأممتهم”.
قال البيهقي: وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس فحضرت الصلاة فأمّهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم اجتمعوا في بيت المقدس. وفي حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في قصة الإسراء أنه لقيهم بالسموات، وطرق ذلك صحيحة، فيحمل على أنه رأى موسى قائمًا يصلي في قبره، ثم عرج به هو ومن ذكر من الأنبياء إلى السموات فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعوا في بيت المقدس فحضرت الصلاة فأمّهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصلاتهم في أوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة لا يرده العقل، وقد ثبت به النقل فدلّ ذلك على حياتهم.
قلت: وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرءان، والأنبياء أفضل من الشهداء. ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه وقال فيه: “وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم” سنده صحيح. وأخرجه أبو الشيخ في “كتاب الثواب” بسند جيد بلفظ: “من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيًا بلغته”، وعن أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة: “فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليّ”، قالوا: يا رسول الله وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرَمتَ؟ قال: “إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء”.
ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه ءاخر عن أبي هريرة رفعه: “ما من أحد يسلم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام” ورواته ثقات. ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصالها عنه وهو الموت، وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: أحدها أن المراد بقوله: “رد الله عليّ روحي” أن ردّ روحه كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد. الثاني: سلمنا، لكن ليس هو نزع موت بل لا مشقة فيه، الثالث: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك، الرابع: المراد بالروح النطق فتجوز فيه من جهة خطابنا بما نفهمه، الخامس: أنه يستغرق في أمور الملأ الأعلى، فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من سلم عليه. وقد استشكل ذلك من جهة أخرى، وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة، وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل، وأحوال البرزخ أشبه باحوال الآخرة، والله أعلم” انتهى كلام الحافظ بحروفه.
وفي كشف الأستار [23] ما نصه: حدثنا يوسف بن موسى ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام” قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “حياتي خير لكم تُحْدِثون ويُحدَث لكم ووفاتي خير لكم يعرض عليّ أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم”. قال البزار: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد. اهـ.
وفي الألفاظ الواردة في السلام على أهل القبور دلالة على ذلك، وذلك في نحو قول الزائر “السلام عليهم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر”. أخرجه الترمذي وحسنه، وما ورد في صحيح مسلم بلفظ السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى ءاخره، فولا صحة سماع الميت لم يكن لهذا الخطاب معنى، ولا حجة في استدلال نفاة التوسل بقول الله تعالى: {وما أنتَ بِمُسمِعٍ مَّن في القُبورِ} [سورة فاطر/22]. فإنه مؤوّل لا يحمل على الظاهر والمراد به تشبيه الكفار بمن في القبور في عدم انتفاعهم بكلامه وهم أحياء، وليس المعنى أنه لا يحصل لأهل القبور سماع شيء من كلام الأحياء على الإطلاق للأخبار الصحيحة. منها ما رواه البخاري أن رسول الله قام على القليب قليب بدرٍ وفيه قتلى المشركين فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء ءابائهم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان قال: إنا وجدنا ما وَعَدَنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا، فقال عمر: ما تُكلِّمُ مِن أجسادٍ لا أرواح لها، فقال رسول الله: “والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع بما أقول منهم”. وكذلك حديث البخاري عن أنس عن النبي: “إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم”.
ثم مما يؤيد صحة سماع الموتى ما رواه الترمذي: أن رجلًا ضرب خباءه [24] ليلًا على قبر فسمع من القبر قراءة {تباركَ الذي بيدهِ المُلكُ} [سورة الملك/1] إلى ءاخرها، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “هي المانعة هي المنجية”. حسنه السيوطي. فإذا كان من على وجه الأرض عند القبر يسمع قراءة صاحب القبر، فأي مانع من أي يسمع صاحب القبر كلام من على وجه الأرض ولو كان في مسافة بعيدة من صاحب القبر بالنسبة لعباد الله الذين منحهم الله الكرامات كما سمع الجيش الذي كان مع سارية في نهاوند صوت عمر وهو على المنبر في المدينة.
وكذلك يؤيد صحة سماع الموتى للأحياء ما قاله الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء [25] ونصه: وقال سعيد بن عبد الله الأودي من بني أود بن سعد العشيرة وفي بعض النسخ الأزدي، فإن كان كذلك فهو سعيد بن عبد الله بن ضرار بن الأزور، وضرار بن الأزور أسدي، ويقال في الأزدي الاسدي، وسعيد ضعيف كما تقدم: شهدت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وهو في النزع فقال: يا سعيد إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “إذا ما مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب –أي لا يستطيع الجواب- ثم ليقل يا فلان ابن فلانة المرة الثانية فإنه يستوي قاعدًا، ثم ليقل يا فلان ابن فلانة المرة الثالثة فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تسمعون”، وفي لفظ: “لا تشعرون، فيقول” وفي لقظ: “فليقل له: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا وبالقرءان إمامًا، فإن منكرًا ونكيرًا يتأخر كل واحد منهما” وفي لفظ: “يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه فيقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لُقِّن حجته ويكون الله عز وجل حجيجه دونهما” وفي لفظ: “ولكن الله حجته دونهم”، فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف اسم أمه قال: “فلينسبه إلى حواء”. أي ليقل: يا فلان ابن حواء. قال العراقي رواه الطبراني بسند ضعيف اهـ. قلت لعله لمكان سعيد بن عبد الله إن كان هو ابن ضرار فقد قال أبو حاتم إنه ليس بقوي نقله الذهبي، هكذا رواه الطبراني في الكبير وفي كتاب الدعاء وابن منده في كتاب الروح وابن عساكر والديلمي، ورواه ابن منده من وجه ءاخر عن أبي أمامة قال: إذا مت فدفنتموني فليقم إنسان عند رأسي فليقل يا صدي بن عجلان اذكر ما كنت عليه في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ورواه ابن عساكر من وجه ءاخر عن أبي أمامة رفعه: “إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع، فليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًا، فليقل يا فلان يا ابن فلانة فإنه سيقول له: أرشدني يرحمك الله، فيقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن الساعة ءاتية لا ريب فيها وأن الله باعث من في القبور، فإن منكرًا ونكيرًا عند ذلك يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول قم ما تصنع عند رجل لُقن حجته فيكون الله تعالى حجيجهما دونه”. اهـ. كلام الزبيدي
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير [25] ما نصه:
قوله: ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن، فيقال: يا عبد الله يا ابن أمة الله، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق، وأن الساعة ءاتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وبالقرءان إمامًا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانًا، ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطبراني عن أبي أمامة: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا، وبالقرءان إمامًا، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقِّن حجته”، قال: فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف أمه؟ قال: “ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء”، وإسناده صالح، وقد قوّاه الضياء في أحكامه. اهـ.
وأما الحي الغائب فإنه يدل على صحة سماعه خطاب من يناديه من بعيد قصة عمر رضي الله عنه في ندائه جيشه الذي كان بأرض العجم بقوله: يا سارية الجبل الجبل، فسمعه سارية بن زنيم وكان سارية قائد الجيش، فانحاز بجيشه إلى الجبل فانتصروا. صححه الحافظ الدمياطي في جزء ألفه لهذه القصة، ووافقه الحافظ السيوطي على ذلك. وأوردها الحافظ الزبيدي فقال في شرح القاموس في فصل السين من باب الواو والياء ما نصه: وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر بن محمية بن عبد بن عدي بن الديل الخلجي الكناني الذي ناداه عمر رضي الله عنه على المنبر وسارية بنهاوند فقال يا سارية الجبل الجبل، فسمع صوته وكان يقاتل العدو فانحاز بهم إلى الجبل، فسلم من مكيدتهم، وهذه الكرامة ذكرها غير واحد من أصحاب السير، وقد ذكره ابن سعد وأبو موسى ولم يذكرا ما يدل له على صحبته لكنه أدرك، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. ومن الدليل على صحة سماع الغائب النداء من بعيد ما ثبت أن ابن عباس قال: قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس كتاب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الآباء وأرحام النساء فأجابه من ءامن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. صححه الحافظ ابن حجر.
فإن قيل: إن كثيرًا من الناس يزورون على عقيدة فاسدة كاعتقاد أن أصحاب الضرائح لهم خصوصية بجلب المنفعة لمن يزورها ودفع المضرة عنهم، على اعتقاد أنهم يستحقون بهذا غاية التذلل.
قلنا: لأجل ظن حصول من نبيتهم هكذا هل يحرم على الجميع بمن فيهم من نيّاتهم صحيحة الذين لا يعتقدون هذا، إنما يعتقدون أن الله جعلها سببًا لحصول بعض المنافع عند الدعاء عندهم، فمثل هذا كمثل السوق فالرسول سماها شر البلاد ومع ذلك لا يحرم على جميع الناس دخولها إنما يحرم على من يذهب ليغش الناس أو يسرق أو ليرابي أو لمقصد محرم غير ذلك فلم يحرم الرسول دخولها على الإطلاق والإجمال بل جعل دخولها حرامًا بحالات مخصوصة، والكعبة حين كان حولها ثلاثمائة وستون صنمًا والمشركون يذهبون إليها ليقدسوها، كان الرسول يذهب للصلاة عند الكعبة، ولم يحرم الذهاب إليها على المؤمنين لأجل وجود الأصنام ومن يعبدها، وهكذا قصد قبور الأولياء للتبرك وقصدها رجاء الإجابة عندها من الله تعالى لا يحكم على كل من دخلها بأنه يعتقد ذلك الاعتقاد الفاسد وأنه يعبد هذه الضرائح.
والعبادة في اللغة غاية التذلل كما قال الراغب الأصبهاني الذي يكثر النقل عنه خاتمة اللغويين مرتضى الزبيدي، وقال أبو حيان الأندلسي في تفسير قوله تعالى: {إياك نعبد} [سورة الفاتحة/5] إن العبادة التذلل عند جمهور اللغويين، وقال ابن السكيت إنها التجريد، ومصيبة جماعتكم جهل معنى العبادة التي يكون بها الإنسان إذا فعلها لغير الله مشركًا، فإذا كان صورة السجود بغير نية غاية التذلل لا يكون إشراكًا في شرعنا إنما يكون حرامًا، فكيف يجعلون مجرد زيارة الشخص قبر ولي أو نبي للتبرك شركًا، وقد ثبت عن معاذ بن جبل أنه سجد لرسول الله فلم يزده على أن قال: “لا تفعل” ولم يقل له أشركت.
والحديث المارّ ذكره الوارد في السوق حديث حسن كما قال الحافظ ابن حجر في الأمالي ورواه مسلم أتمّ من هذا اللفظ مع مغايرة في اللفظ.
ثم إن التوسل والتوجه والاستغاثة مؤداها واحد كما قال الحافظ تقي الدين السبكي وهو من اللغويين كما قال السيوطي، وذلك ظاهر، فإن الصحابي الذي ذهب إلى قبر رسول الله في عام الرمادة فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، يصح أن يطلق على فعله التوسل والاستغاثة، فإنه ذهب إلى قبر الرسول لقصد أن يطلب من الرسول إنقاذهم من الشدة التي أهلكتهم بطلب السقيا من الله.
وهذا الحديث رواه البيهقي بإسناد صحيح [26] عن مالك الدار [وكان خازن عمر] قال: “أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقِ لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأُتيَ الرجل في المنام فقيل له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون وقل له: عليك الكيس الكيس، فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر وقال: “يا ربّ ما ءالوا إلا ما عجزت”. وهذا الرجل هو بلال بن الحارث المزني الصحابي، فهذا الصحابي قد قصد قبر الرسول للتبرك والاستغاثة قلم ينكر عليه عمر ولا غيره.
وفي فتح الباري [27] ما نصه: “وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار –وكان خازن عمر- قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأُتي الرجل في المنام فقيل له: ائتِ عمر… الحديث. وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة” اهـ.
وفي البداية والنهاية لابن كثير [28] ما نصه: “وقد روينا أن عمر عسّ المدينة ذات ليلة [29] عام الرمادة فلم يجد أحدًا يضحك، ولا ينحدث الناس في منازلهم على العادة، ولم يرَ سائلًا يسأل، فسأل عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إنّ السؤّال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السؤال، والناس في همّ وضيق فهم لا يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمة محمد، وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن يا غوثاه لأمة محمد، فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البُرّ وسائر الأطعمات، ووصلت ميرة عمرو في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. وهذا الأثر جيد الإسناد” اهـ. وهذا فيه الرد على ابن تيمية لقوله إنه لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، فهذا عمر بن الخطاب استغاث بأبي موسى وعمرو بن العاص وهما غائبان.
ثم يقولُ في الصحيفة التي تليها: وقال سيفُ بن عمر: عن سهل بن يوسف السلمي، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في ءاخر سنة سبع عشرة وأوّل سنة ثماني عشرة أصاب أهل المدينة وما حولها جوع فهلك كثير من الناس حتى جعلت الوحش تأوي إلى الأنس، فكان الناس بذلك وعمرُ فاستأذن على عمر فقال: أنا رسولُ رسول الله إليك، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لقد عهدتك كيسًا، وما زلتَ على ذلك فما شأنك”. قال: متى رأيت هذا؟ قال: البارحة، فخرج فنادى في الناس: الصلاة جامعة، فصلى بهم ركعتين ثم قام فقال: أيها الناس أنشدكم الله هل تعلمون مني أمرًا غيره خيرًا منه فقالوا: اللهم لا، فقال: إنّ بلال بن الحارث يزعم ذَيْتَ ذَيْتَ [30] قالوا: صدق بلال فاستغث بالله ثم بالمسلمين، فبعث إليهم وكان عمر عن ذلك محصورًا، فقال عمر: الله أكبر، بلغ البلاء مدته فانكشفت، ما أُذن لقوم في الطلب إلا وقد رفع عنهم الأذى والبلاء. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيثوا أهل المدينة ومَن حولها فإنه قد بلغ جهدهم، وأخرج الناس إلى الاستسقاء، فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشيًا، فخطب وأوجز وصلى ثم جثى لركبتيه وقال: اللهم إياك نعبدُ وإياك نستعين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضَ عنا. ثم انصرف، فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا الغدران.
ثمّ روى سيفٌ عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلًا من مزينة عام الرمادة سأله أهله فإذا عظامها حمرٌ فقال: يا محمداه، فلمّا أمسى أُريَ في المنام أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ له: “أبشر بالحياة، إيت عمر فأقرئه مني السلام وقل له: إنّ عهدي بك وفيّ العهد شديدَ العقدِ فالكيس الكيس يا عمر”. فجاء حتى باب عمر فقال لغلامه: استأذن لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي عمر فأخبره، ففزع ثم صعد عمر المنبر فقال للناس: أنشدكم الله الذي هداكم للإسلام هل رأيتم مني شيئًا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم لا، وعمّ ذاك؟ فأخبرهم بقول المزني –وهو بلال بن الحارث- ففطنوا ولم يفطن، فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء فاستسق بنا، فنادى في الناس فخطب فأوجز ثمّ صلى ركعتين فأوجز ثم قال: اللهم عجزت عنا أنصارنا وعجز عنّا حولنا وقوتنا، وعجزت عنّا أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اسقنا وأحيِ العباد والبلاد.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقِ لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: “إيت عمر فأقرئه مني السلام وأخبرهم أنهم مُسقون وقل له: عليك بالكيس الكيس”، فأتى الرجل فأخبر عمر فقال: “يا رب ما ءالوا إلا ما عجزت عنه”. هذا إسناد صحيح” اهـ. وهذا إقرار بصحة هذا الحديث من الحافظ ابن كثير.
ومنكرو التوسل أتباع ابن تيمية يقولون لماذا تجعلون واسطة بقلوكم: اللهم إني أسألك بعبدك فلان؟ الله لا يحتاج إلى واسطة؟ يقال لهم: الواسطة قد تأتي بمعنى المعين والمساعد وهو محال بالنسبة إلى الله تعالى، أما الواسطة بمعنى السبب فالشرع والعقل لا ينفيانه، فالله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، جعل الأدوية أسبابًا للشفاء، وهو خالق الأدوية وخالق الشفاء بها، كذلك جعل الله تعالى التوسل بالأنبياء والأولياء سببًا لنفع المتوسلين، ولولا أن التوسل سبب من أسباب الانتفاع ما علّم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمى التوسل به، ثم الله تعالى هو خالق التوسل وخالق النفع الذي يحصل به بإذن الله، فالتوسل بالأنبياء والأولياء من باب الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب إما ضرورية كالأكل والشرب، وإما غير ضرورية كالتوسل، وكل من جملة الأسباب. والمؤمن الذي يتوسل بالأنبياء والأولياء لا يعتقد أن كونهم وسطاء بينه وبين الله بمعنى أن الله يستعين بهم في إيصال النفع للمتوسل أو أنه لا يستقلّ بذلك، بل يراهم أسبابًا جعلها الله لحصول النفع بإذنه.
ثم إن مقصود المتوسل قد يحصل وقد لا يحصل كما أن الذي يتداوى بالأدوية قد يحصل له الشفاء بها وقد لا يحصل، كذلك زيارة قبور الأنبياء والأولياء للتبرك رجاء إجابة الدعاء عندها جعلها الله سببًا لحصول المنفعة وذلك معلوم بين المسلمين عوامهم وخواصهم، ما كان ينكره أحد قبل ابن تيمية، ومن ذلك قصة الصحابي الذي زار قبر النبي عام الرمادة، وقد مرّ ذكرها قبل قليل وثبوت صحتها كما قال البيهقي وابن كثير.
فقول هؤلاء المنكرين لمَ تجعلون وسائط بينكم وبين الله، ولم لا تطلبون حاجاتكم من الله، كلام لا معنى له، لأن الشرع رخّص للمؤمن بين أن يطلب من الله حاجته بدون توسّل وبين أن يطلب حاجته مع التوسل، فالذي يقول: اللهم إني أسألك بنبيك، أو: بجاه نبيك، أو نحو ذلك، فقد سأل الله، كما أن الذي يقول: اللهم إني أسألك كذا وكذا قد سأل الله، فكلا الأمرين سؤال من العبد ربه، وكلاهما داخل تحت حديث: “إذا سألت فاسأل الله”.
فالأمر ليس كما تزعمون أيها التيميون، وكل ما يحصل منكم منذ أن نشر ابن تيمية في الناس هذا الاعتقاد الفاسد فيما يتعلق بالتوسل وزيارة القبور للتبرك من تضليل وتكفير فوباله عليكم وعلى إمامكم، لأن ذلك داخل تحت حديث: “ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده”.
هذا وقد صرح ابن تيمية في غير موضع بأن قصد القبر للدعاء عنده بدعة قبيحة. قال البُهوتي صاحب كشاف القناع [31] نقلًا عن صاحب الفروع ما نصه: “وقال شيخنا –يعني ابن تيمية-: قصده –يعني القبر- للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة” اهـ. وصاحب الفروع هو شمس الدين بن مفلح الحنبلي وهو من تلامذة ابن تيمية، وقال في موضع ءاخر من كشاف القناع: قال الشيخ –يعني ابن تيمية-: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقًا، ثم قال: واتفقوا على أنه لا يقبّله ولا يتمسّح به، فإنه من الشرك، وقال: والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر اهـ. هذه عبارته التي نقلها عنه البهوتي، وفي طيّ هذا الكلام تكفير أبي أيوب الأنصاري الذي ثبت أنه وضع جبعته على قبر الرسول، فرءاه مروان بن الحكم فأخذ برقبته فالتفت إليه أبو أيوب فمضى مروان، فقال أبو أيوب: إني لم ءات الحجر، وإنما أتيت رسول الله، إني سمعت رسول الله يقول: “لا تبكوا على الإسلام إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله”. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. فإذا كان وضع الوجه على القبر من أبي أيوب لم يستنكره أحد من الصحابة، فماذا يقول ابن تيمية؟ هل يكفّر أبا أيوب أم ماذا يفعل؟ ثم ماذا يفعل بنص الإمام أحمد الذي نقله عنه ابنه عبد الله في كتابه العلل ومعرفة الرجال [32] قال: سألته –يعني سأل أباه الإمام أحمد- عن الرجل يمسّ منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرب إلى الله جل وعز فقال: لا بأس بذلك.
قال البهوتي [33]: “ولا بأس بلمسه –أي القبر- باليد وأما التمسح به والصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدًا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره، أو النذر له أو نحو ذلك، فقال الشيخ –يعني ابن تيمية- فليس من دين المسلمين بل هو مما أُحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك قال –يعني ابن تيمية- في الاختيارات: اتفق السلف والأئمة على أن من سلّم على النبي أو غيره من الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسّح بالقبر ولا يقبله، بل اتفقوا على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود، والركن اليماني يُستلك ولا يقبل على الصحيح. ثم قال البهوتي ردًا على ابن تيمية: قلت: بل قال إبراهيم الحربي: يستحب تقبيل حجرة النبي اهـ. والبهوتي حنبلي لكنه لما علم أن كلام ابن تيمية غير صحيح رده عليه، فأبطل بذلك دعواه اتفاق السلف على منع تقبيل القبر، وهو لم يدرك ابن تيمية، وقد توفي بعد الألف.
قال صاحب غاية المنتهى الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي [34] ما نصه: “ولا بأس بلمس قبر بيد لا سيما من ترجى بركته”. اهـ.
وقال المرداوي في الإنصاف [35] ما نصه: “يجوز لمس القبر من غير كراهة، قدمه في الرعايتين، والفروع، وعنه يكه، وأطلقهما في الحاويين، والفائق، وابن تميم، وعنه يستحب قال أبو الحسين في تمامه: وهي أصح” اهـ. فبهذا تبين أن ابن تيمية شذّ عن الإمام أحمد الذي كان ينتسب إليه وأهل مذهبه الذين قبله كما شذ عن سائر المسلمين.
وقال السمهودي في وفاء الوفا [36] ما نصه: لما قدم بلال رضي الله عنه من الشام لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، وإسناده جيد كما سبق.
وفي تحفة ابن عساكر من طريق طاهر بن يحيى الحسيني قال: حدثني أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: لما رُمِسَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها فوقفت على قبره صلى الله عليه وسلم وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينها وبكت، وأنشأت تقول:
ماذا على مَنْ شمَّ تربةَ أحمدٍ *** أنْ لا يَشُمَّ مدى الزمانِ غَواليا
صُبَّتْ عليَّ مصائبٌ لو أنها *** صبت على الأيام عُدْنَ لياليا
ذكر الخطيب بن حملة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده اليمنى على القبر الشريف، وأن بلالًا رضي الله عنه وضع خديه عليه أيضًا، ثم قال: ورأيت في كتاب السؤالات لعبد الله ابن الإمام أحمد وذكر ما تقدم عن ابن جماعة نقله عنه، ثم قال: ولا شك أن الاستغراق في المحبة يحمل على الإذن في ذلك.
وقال الحافظ ابن حجر استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الأسود جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من ءادمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فسبق في الأدب، وأما غيره فنقل عن أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره فلم ير به بأسًا، واستبعد بعض أتباعه صحته عنه ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، ونقل الطيب الناشري عن المحب الطبري أنه يجوز تقبيل القبر ومسه قال وعليه عمل العلماء الصالحين اهـ كلام السمهودي.
وفي عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني [37] ما نصه: وقال –يعني شيخه زين الدين- أيضًا: وأخبرني الحافظ أبو سعيد بن العلائي قال رأيت في كلام أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن الإمام أحمد سُئل عن تقبيل قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتقبيل منبره فقال: لا بأس بذلك، قال فأريناه للشيخ تقي الدين بن تيمية فصار يتعجب من ذلك ويقول عجبت أحمد عندي جليل يقوله [38] هذا كلامه أو معنى كلامه، وقال: وأيّ عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل قميصًا للشافعي وشرب الماء الذي غسله به وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم فكيف يمقادير الصحابة وكيف بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وقال المحب الطبري: ويمكن أن يستنبط من تقبل الحجر واستلام الأركان جواز تقبيل ما في تقبيله تعظيم الله تعالى فإنه إن لم يرد فيه خبر بالندب لم يرد بالكراهة. قال: وقد رأيت في بعض تعاليق جدي محمد بن أبي بكر عن الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي الصيف أن بعضهم كان إذا رأى المصاحف قبّلها وإذا رأى أجزاء الحديث قبّلها وإذا رأى قبور الصالحين قبلها، قال: ولا يبعد هذا والله أعلم في كل ما فيه تعظيم لله تعالى اهـ.
وفي مصنف ابن أبي شيبة [39]: حدثنا أبو بكر –يعني ابن أبي شيبة- قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني أبو مودودة قال: حدثني يزيد بن عبد الملك بن قسيط قال: رأيت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر [40] القرعاء [41] فمسحوها ودعوا، قال: ورأيت يزيد يفعل ذلك اهـ.
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم [42]: فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده اهـ. فماذا تقول الوهابية بعد هذا، هل توافق زعيمها الاول أم لا تتبعه، فيا لها من فضيحة عليهم.
وفي سير أعلام النبلاء للذهبي [43] ما نصه: قال عبد الله بن أحمد: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يُقبّلها. وأحسب أني رأيته يضعها على عينه، ويغمسها في الماء ويشربه يستشفي به. ورأيته أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جبّ الماء ثم شرب فيها، ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه. قلت: أين المتنطِّع المنكِر على أحمد، وقد ثبت أن عبد الله سأل أباه عمن يلمس منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويمس الحجرة النبوية، فقال: لا أرى بذلك بأسًا. أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع اهـ.
وفي شرح الإحياء للحافظ الزبيدي [44] ما نصه: قال محمود بن محمد حدثنا الميمون حدثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي قال: حضرت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني قد أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثًا ولا أدري ما حالي عنده فلا تدفنوني معه، فإني أكره أن أجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما حالي عنده، ثم دعت بخرقة من قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ضعوا هذه على صدري وادفنوها معي لعلي أنجو بها من عذاب القبر اهـ.
وفي البداية والنهاية لابن كثير [45] ما نصه: قال أحمد فعند ذلك قال لي: -يعني قال له المعتصم حين طالبه بالقول بخلق القرءان فامتنع أحمد- لعنك الله، طمعت فيك أن تجيبني فلم تجبني، ثم قال: خذوه واخلعوه واسحبوه، قال أحمد: فأخذت وسحبت وخلعت وجيء بالعاقبين والسياط وأنا أنظر، وكان معي شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مصرورة في ثوبي، فجردوني منه وصرت بين العقابين اهـ.
وفي كشف الأستار عن زوائد البزار [46] ما نصه: باب دفن الآثار الصالحة مع الميت: حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد، ثنا مخول بن إبراهيم، ثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أنس أنه كانت عنده عُصيَّة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمات فدفنت معه بين جيبه وقميصه. قال البزار تفرَّد به مخول وهو صدوق شيعي، احتمل على ذلك اهـ.
قال الحافظ الزبيدي في الإتحاف [47] ما نصه: ويروى أن ءاخر خطبة خطبها معاوية إذ قال: أيها الناس إني من زرع قد استحصد وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد من بعدي إلا وهو شرّ مني كما كان من قبلي خيرًا مني، ويا يزيد –يعني ولده- إذا وفى أجلي فولّ غسلي رجلًا لبيبًا فإن اللبيب من الله بمكان، فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير، ثم اعمد –أي اقصد- إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقراضة من شعره وأظفاره، فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيني، واجعل الثوب على جلدي دون أكفاني اهـ.
هذا وقد صرح بعض الحنابلة كأبي الفرج بن الجوزي وشيخه ابن عقيل بأنه يكره قصد القبور للدعاء، لكنهما لم يحرما، ولم يحرم أحد من السلف ولا الخلف ذلك، إنما الذي ورد عن بعض العلماء هو الكراهة وليس التحريم. أما ابن تيمية فقد طغى قلمه فزاغ عن الصواب إلى تكفير المسلمين بذلك. ومن تتبع تراجم المحدثين والعلماء يجد الكثير منها فيه أن فلانًا من المحدثين أو الصالحين دفن ببلد كذا وأنه يُزار قبره وتستجاب الدعوة عنده، من ذلك ما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، يقول ابن عساكر: ودفن بنيسابور وقبره يُزار وتُجاب الدعوة عنده. وقد تقدم أن إبراهيم الحربي قال: “وقبر معروفٍ الترياق المجرب”، ذكر ذلك الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد.
وذكر المحدث الحافظ شيخ القراء شمس الدين بن الجزري في كتابه الحصن الحصين ومختصره عُدّة الحصن الحصين أن من مواضع إجابة الدعاء قبور الصالحين، وهو بعد ابن تيمية من أقران الحافظ ابن حجر العسقلاني.
فأنّى لابن تيمية أن يحكم على هذا الامر المتواتر بين المسلمين خواصهم وعوامهم بأنه شرك. سبحانك هذا بهتان عظيم.
فبهذا يتبين أن ابن تيمية قد نسب رأيه الذي يهواه إلى الائمة، وادّعى الاتفاق على ذلك بغير حجة، فليعلم ذلك من اخذ من الناس بقول ابن تيمية فحكم على من يقصد قبر الرسول وغيره للدعاء عنده بأن زيارة القبر بهذه النية شرك وكفر، فليحذر ذلك وليدع التقليد الأعمى، إنما الأمر ما قاله الحافظ السبكي: ويستحسن التوسل بالنبي ولم ينكره أحد من السلف ولا من الخلف غير ابن تيمية، فقال ما لم يقله عالم قبله.
وأما احتجاجهم بقطع عمر رضي الله عنه شجرة بيعة الرضوان لتحريمهم التبرك بقبور الأنبياء والصالحين فليس في ذلك دليل لهم، فإنه محمول على أنه تخوّف أن يأتي بآثار زمان قد يعبد الناس تلك الشجرة، وليس مقصوده تحريم التبرك بآثار الرسول، ولو كان الأمر كما طنوا ما كان ابنه عبد الله يأتي إلى شجرة سَمُرٍ التي كان الرسول ينزل تحتها، فكان عبد الله ينزل تحتها أي تبركًا، وكان يسقيها الماء كي لا تيبس –رواه ابن حبان وصححه- ولا شك أن عبد الله بن عمر أفهم بسيرة أبيه من ابن تيمية وأتباعه.
قال البخاري في صحيحه [48] ما نصه: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأماكن، وسألت سالمًا فلا أعلمه إلا وافق نافعًا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحلية، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن وادٍ، فإذا ظهر من بطن وادٍ أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرَّس ثَمَّ حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منتصف الروحاء وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتُني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه على يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مرَّ به قبل الصبح بساعة أو من ءاخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح، وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاء الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كثب كثيرة، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرق تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشى ذلك المسيل لاصق بكراع هرشى بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مرّ الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق إلا رمية بحجر، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت بها حتى يصبح يصلي الصبح حتى يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة، وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الاكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة اهـ. نص البخاري رحمه الله تعالى. قال الحافظ الزبيدي [49] وإنما كان ابن عمر يصلي في هذه المواضع للتبرك. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر [50]: ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن، وتشدده في الاتباع مشهور، ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك فقالوا: قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعًا، لأن ذلك من عمر محمول على أن كره زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبًا، وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم حديث عتبان وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذه مصلى وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين اهـ.
وإننا نتحدى من يتعصب لكلام ابن تيمية على الاتيان بنقل صحيح من إمام من السلف أو الخلف حرّم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك أو التوسل به في حياته أو بعد مماته، ولن يجدوا ذلك، ولهذا خالف ابن كثير شيخه ابن تيمية في مسألة التوسل، وكان يتبعه في مسائل الطلاق فعذّب لذلك، فصرح في تفسيره باستحسان التوسل بالنبي بعد موته والاستغاثة به، كما ذكر ذلك في تاريخه البداية والنهاية في ترجمة عمر بن الخطاب.
واستدلالهم بحديث: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا” لتحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم جوابه: أن أحدًا من السلف لم يفهم ما فهمه ابن تيمية، بل زيارة قبر الرسول سنة سواء كانت بسفر أو بغير سفر كسكان المدينة، والحنابلة قد نصوا كغيرهم على كون زيارة قبر النبي سواء قصدت بالسفر لأجلها أو لن تقصد بالسفر لأجلها.
وأما الحديث فمعناه الذي فهمه السلف والخلف أنه لا فضيلة زائدة في السفر لأجل الصلاة في مسجد إلا السفر إلى هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف فيها إلى مائة ألف وذلك في المسجد الحرام وإلى ألف وذلك في مسجد الرسول وإلى خمسمائة وذلك في المسجد الأقصى. فالحديث المراد به السفر لأجل الصلاة، يبين ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من طريق شهر بن حوشب من حديث أبي سعيد مرفوعًا: “لا ينبغي للمطي أن تُعمَلَ إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة إلا إلى المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا” وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر، وهو مبين لمعنى الحديث السابق، وتفسير الحديث بالحديث خير من تحريف ابن تيمية، قال العراقي في ألفيته في مصطلح الحديث:
وخيرُ ما فسَّرتُهُ بالوارِدِ
قال الشيخ عبد الغني النابلسي في كتابه الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية ما نصه [51]: وليس هذا بأوَّل ورطةٍ وقع فيها ابن تيمية وأتباعه فإنه جعل شد الرحال إلى بيت المقدس معصية كما تقدم ذكر ذلك وردّه، ونهى عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى وبغيره من الأولياء أيضًا، وخالف الإجماع من الأئمة الأربعة في عدم وقوع الطلاق الثلاث بلفطة واحدة، إلى غير ذلك من التهورات الفظيعة الموجبة لكمال القطيعة التي استوفاها الشيخ العلامة العمدة الفهامة، تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب مستقل في الرد على ابن تيمية وأتباعه وصرح فيه بكفره.
ثم قال: قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر في كتابه “الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم”، بعد أن تكلم في شأن ابن تيمية بكلام كثير: ولقد تصدى شيخ الإسلام وعالم الأنام، المجمع على جلالته واجتهاده وصلاحه وأمانته، التقي السبكي قد الله روحه، للرد عليه في تصنيف مستقل أفاد فيه وأجاد وأصاب، وأوضح بباهر حججه طريق الصواب، فشكر الله مسعاه، وأدام عليه شآبيب رحمته ورضاه، انتهى.
والذي أوقع ابن تيمية في هذا التحريف هو سوء فهمه، فهو كما قال فيه الحافظ ولي الدين العراقي: علمه –أي ابن تيمية- أكبر من عقله، ذكره في كتابه الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية، وقد مرّ ذلك. وابن تيمية قد ذكر أن احاديث الزيارة كلها كذب انظروا إلى هذا الافتراء، فقد ذكر السيوطي في مناهل الصفاء أن حديث: “من زار قبري وجبت له شفاعتي” قال الذهبي فيه إنه يتقوى بتعدد الطرق، فكيف تجرأ ابن تيمية على قوله إن أحاديث الزيارة كلها كذب لم يستح من الله ولا من رسوله ولا من علماء الحديث، ألم يعلم بأن من حفاظ الحديث الذين سبقوه من ألّف كتابًا سماه السنن الصحاح وهو الحافظ سعيد بن سَكَن أودع كتابه حديثًا في الزيارة، وهذا الحافظ ابن حجر الذي جاء بعد ابن تيمية استحسن كلام الحافظ تقي الدين السبكي حيث أورد أحاديث الزيارة لم ينتقده فيما فعله من تصحيح بعض أحاديثها، فهذا الكذب من ابن تيمية إحدى وقاحاته التي تدل على أنه متكبر، حتى إنه تجرأ بها على تكذيب سيبويه، كان أبو حيان الأندلسي قال في مجلس ابن تيمية: هكذا قال سيبويه، فقال ابن تيمية: يكذب سيبويه، أوردها صلاح الدين الصفدي كما تقدم في تاريخه الذي ترجم فيه ابن تيمية التي فيها ثناء عليه، وكان هو من جملة من كان يتردد لحضور دروس ابن تيمية كما ذكر ذلك عن نفسه في كتابه في التاريخ المسمى أعيان العصر وأعوان النصر، وحديث: “ليسكن عيسى ابن مريم حاجًا أو معتمرًا وليأتين قبري حتى يسلم عليّ ولأردنَّ عليه” صححه الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. فقد ظهر أنه فضح نفسه بتكذيبه لهذا الحديث وعادت صفة الكذب عليه. وقد استوفى الحافظ ابن حجر أحاديث الزيارة في تخريج الأذكار. فيا أيها المغرورون بابن تيمية اعلموا أنكم قد ضللتم بعقيدتكم هذه التي تلقيتموها منه، وقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف بعد السلام على الرسول وصاحبيه ودعائه لهما ويدعو، صحح ذلك الحافظ ابن حجر في أماليه وإليك أيها المطالع عبارة ابن حجر من الأمالي قال نقلًا عن النووي:
فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فإن زيارته من أهم القربات. قلنا: -يعني ابن حجر نفسه- استدل الشيخ في المهذب لاستحبابها بحديث ابن عمر، قال الشيخ في شرحه: أخرجه الدارقطني والبيهقي بسندين ضعيفين، قلت: مرجع كل منهما إلى راوٍ واحد فيه الكلام كما سيأتي، وله طريق أخرى إلى ابن عمر عند البزار، وجاء في الباب عدة أحاديث عن غيره من الصحابة اعتنى بجمعها والكلام عليها تعديلًا وتجريحًا وتعليلًا وتصحيحًا شيخ شيوخنا السبكي الكبير في كتابه شفاء السقام في زيارة النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم قال: أخبرني الزين أبو محمد عمر بن محمد بن أحمد بن سليمان البالسي ثم الصالحي قيما قرأت عليه بدمشق عن أبي بكر بن أحمد الدقاق سماعًا قال: أنا علي بن أحمد بن عبد الواحد قال: أنا محمد بن معمر إجازة مكاتبة من أصبهان قال: أنا إسماعيل بن الفضل قال: أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم قال: ثنا علي بن عمر الدارقطني الحافظ قال: ثنا الحسين بن إسماعيل قال: ثنا عبيد بن محمد الوراق قال: ثنا موسى بن هلال العبدي قال: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع [ح] وأخبرنا عاليًا أبو بكر بن إبراهيم عن أبي عمر قال: أنا أبو المعالي بن الحسين بن أبي التائب وأبو بكر بن محمد بن عنتر وزينب بنت يحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال الأول: أنا محمد بن أبي بكر البلخي عن السلفي وقال الآخران: أنا عبد الرحمن بن مكي في كتابه قال: أنا جدي لأمي الحافظ أبو الطاهر السلفي قال: أبا أبو سعد أحمد بن الحسن الجرباذقاني بها قال: أنا أبو بكر بن الفضل المقري قال: أنا نحمد بن الحسن بن يوسف قال: أنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم الرازي قال: ثنا موسى بن هلال قال: ثنا عبد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من زار قبري وجبت له شفاعتي”. هذا حديث غريب أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن عبيد بن محمد الوراق فوقع لنا موافقة عالية، وأخرجه أيضًا عن محمد بن إسماعيل الأحمسي بمهملتين عن موسى بن هلال فوقع لنا بدلًا عاليًا، وتوقف ابن خزيمة فيه فقال إن ثبت الخبر، فإن في القلب من هذا السند وأنا أبرأ إلى الله من عهدته، ووقع عنده في زمانه عبيد الله بن عمر بالتصغير كما سقناه وعن الأحمسي عبد الله بن عمر بالتكبير أشبه لأن عبيد الله يعني المصغر أجلّ وأعلم وأحفظ من أن يروي هذا المنكر، قلت: إنما أطلق عليه اسم المنكر وفاقًا لقول مسلم علامة المنكر أن ينفرد راوٍ عن إمام مكثر من الحديث والرواة عنه بشيء لا يوجد عند أحد منهم كالزهري ونافع وغيرهما من المكثرين، ثم جوّز ابن خزيمة أن يكون موسى إن كان حفظ عبيد الله بالتصغير غلط في نافع، وقد اغترّ من لا يد له في الفن فقال: صححه ابن خزيمة وأغفل كلامه مع وضوحه، وقد جاء هذا الخبر من طريق مسلمة بن سالم الجهني عن عبيد الله بن عمر بالتصغير، لكنه خالف في السند فزاد سالمًا بين نافع وابن عمر، فقد خالف في المتن أيضًا وهو ضعيف عندهم.
أخبرنا أبو هريرة ابن الحافظ شمس الدين الذهبي إجازة غير مرة وقرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي كلاهما عن يحيى بن الصباح قال: أنا عبد الله بن رفاعة قال: أنا أبو الحسن الخلعي قال: أنا أبو النعمان تراب بن عمر قال: ثنا علي بن عمر الحافظ إملاء قال: ثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: ثنا عبد الله بن محمد العُبادي –بضم المهملة وتخفيف الموحدة- قال: ثنا مسلمة بن سالم بن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من جاءني زائرًا لم تنزعه حاجة إلا زيارتي كان حقًا عليّ أن أكون له شفيعًا يوم القيامة” هذا حديث غريب أخرجه الطبراني عن الحسين بن إسحاق عن العبادي فوافقناه في شيخ شيخه، ووجدت متابعًا للمتن الأول أخرجه البزار من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر ولفظه: “من زار قبري حلت له شفاعتي” قال البزار: لم نكتبه إلا من رواية عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن وهما ضعيفان. والله أعلم.
ثم قال ذكر طريق ءاخر لحديث ابن عمر مقيدة لمن حج، قرأت على أبي المعالي عبد الله بن عمر بن علي الحلاوي رحمه الله عن أم عبد الله الكمالية أو يوسف بن خليل الحافظ أخبرهم في كتابه قال: أنا أبو سعيد بن أبي الرجل قال: أنا أبو علي المقري قال: أنا أبو نعيم الاصبهاني قال: أنا الطبراني في المعجم الأوسط قال: ثنا جعفر بن بجير بموحدة وجيم مصغرة قال: ثنا محمد بن بكار بن الريان [ح] وبالسند الماضي قريبًا إلى الدارقطني قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز هو البغوي قال: ثنا أبو الربيع الزهراني قال: ثنا حفص قال الأول ابن سليمان وقال الثاني ابن أبي داود قال: ثنا ليث بن أبي سُليم عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من حج فزار قبري كان كمن زارني في حياتي” هذا حديث غريب أخرجه سعيد بن منصور في السنن عن حفص بن سليمان، وأخرجه أحمد بن عدي عن البغوي فوقع لنا موافقة فيهما قال ابن عدي حفص بن سليمان هو حفص بن أبي داود كان أبو الربيع يكني إياه بضعف حفص، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن الحسين بن إسحاق عن البغوي، وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق الصغاني عن محمد بن بكار كما أخرجناه وقال: تفرّد به حفص بن سليمان وهو ضعيف، وكذا ابن عدي وهو حفص القارئ ضعفوه في الحديث جدًا مع إمامته في القراءة، وقد أطلق الطبراني أيضًا أن حفصًا تفرد به، ثم ناقض فأخرجه من وجه ءاخر عن ليث قرأت على أبي الحسن علي بن محمد بن الصايغ عن إسحاق بن يحيى الدمشقي قال: أنا أبو الحجاج الآدمي قال: أنا أبو عبد الله بن أبي زيد قال: أنا محمود بن إسماعيل قال: أنا أحمد بن محمد قال: أنا سليمان بن أحمد قال: ثنا أحمد بن رشدين قال: ثنا علي بن الحسن بن هارون الانصاري قال: ثنا الليث ابن بنت ليث بن أبي سليم قال: حدثتني عائشة بنت يونس امرأة ليث بن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، فذكر الحديث كما مضى لكنه لن يقل في أوله: من حج، قال الطبراني في الأوسط: لا يروي عن ليث بن أبي سليم إلا بهذا الإسناد، قلت: وهذا الحصر مردود برواية حفص وسند روايته ليس فيه إلا هو، أما الثاني فمن شيخ الطبراني وهو أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين إلى ليث بن أبي سليم، إما ضعيف وإما مجهول، وقد ورد من طريق ثالثة عن ليث لكن السند معلول أخرجه أبو يعلى من طريق حسان بن إبراهيم عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير –بكسر المعجمة أوله وثالثه وبينهما نون ساكنة وقبل الراء مثناة من تحت ساكنة- عن ليث بن أبي سليم، وقد اتفقوا على أن ذكر كثير فيه وهم فهو من المزيد في متصل الأسانيد. والله اعلم.
وورد في ءاخر هذه الرواية ما أنبأنا أبو علي الفاضلي شفاهًا قال: أنا يونس بن إسحاق إجازة إن لم يكن سماعًا عن أبي الحسن المقيري كذلك قال: أنا أبو الكرم الشهرزوري في كتابه قال: أنا إسماعيل بن مسعدة قال: أنا حمزة بن يوسف قال: ثنا أبو أحمد الجرجاني قال: ثنا الحسن بن سفيان قال: ثنا علي بن حجر قال: ثنا حفص بن سليمان فذكر الحديث وفي ءاخره: “كان كمن زارني في حياتي وصحبني” وهكذا أخرجه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الترجمة النيرة عن أبي القاسم بن السمرقندي عن إسماعيل بن مسعدة فوقع لنا بدلًا عاليًا وقال: هذه زيادة منكرة، قلت: كأن راويها ذكرها بالمعنى لأن لازم من زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنًا به أن يكون صحابيًا فصحّ التشبيه، ومما يلتحق بذلك ما اشتهر على الألسنة: “من حج ولم يزرني فقد جفاني” أخرجه ابن عدي وابن حبان في كتابيهما في الضعفاء والدارقطني في العلل، كلهم من حديث ابن عمر أيضًا وفي سندهم النعمان شبل وقد اتهم بالكذب وأورد ابن الجوزي حديثه هذا في الموضوعات.
ذكر حديث ءاخر في أصل الباب: أخبرني الإمام أبو الفرج بن حماد قال: أنا أحمد بن منصور الجوهري قال: أنا أبو الحسن بن البخاري عن أبي المكارم اللبان قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا الحافظ أبو نعيم قال: أخبرنا أبو محمد بن فارس قال: ثنا يونس بن حبيب قال: ثنا أبو داود الطيالسي قال: ثنا سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال: حدثني رجل من ءال عمر عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من زار قبري كنت له شفيعًا أو شهيدًا، ومن مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة” هذا حديث غريب أخرجه البيهقي عن أبي بكر بن فورك عن ابن فارس وقال: هذا إسناد مجهول، قلتُ قال بعض ليس فيه إلا الذي لم يُسمّ، وأما سوار فورى عنه أيضًا شعبة وهي كافية في توثيقه، قلت: لكن لم يترجم له البخاري ولا من تبعه ولا ذكره أبو أحمد في الكنى، وقد اختلف عليه في هذا الحديث سندًا ومتنًا فأخرجه العقيلي في الضعفاء من طريق عبد الملك الجدي عن شعبة عن سوار بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل من ءال الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة” هكذا أورده في ترجمة هارون ونقل عن البخاري أنه قال: لا يتابع عليه، قلت: لكن لفظ البخاري عن رجل من أهل حاطب –بإهمال الحاء وتقديم الألف على الطاء- واستفدنا من هذه الرواية أن هارون سقط من الرواية الأولى، وقد جاء من وجه ءاخر بسند أتم قرأت على الزين عمر البالسي بدمشق عن أبي بكر الدقاق سماعًا قال: أنا علي بن أحمد السعدي عن محمد بن معمر قال: أنا إسماعيل بن الفضل قال: أنا محمد بن أحمد قال: ثنا علي بن عمر قال: أبا عبيد بن إسماعيل عن المحاملي وأخوه الحسين قالا: ثنا محمد بن وليد قال: ثنا وكيع عن خالد بن أبي خالد وأبي عون عن الشعبي وأسود بن ميمون عن هارون أبي قزعة عن جرل من ءال حاطب عن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين…” الحديث، وهكذا أخرجه ابن عساكر من طريق زكريا الساجي عن محمد بن الوليد وهذا السند أشبه بالصواب مما قبله. وحدث: “من مات في احد الحرمين” له طرق أخرى يقوى بعضها ببعض وله شاهد صحيح عن ابن عمر. والله أعلم.
أخبرني أبو داود سليمان بن أحمد بن عبد العزيز المدني بها رحمه الله تعالى قال: أنا أحمد بن علي العابد قال: أنا عبد الحميد بن عبد الهادي قال: أنا يوسف بن معالي قال: أنا أبو الحسن بن قبيس قال: أنا أبو الحسين بن علي الأنطاكي قال: أنا تمام بن محمد قال: ثنا أبو الطيب محمد بن حميد الحوراني قال: ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي ومحمد بن عبد الله الرقاشي قالا: ثنا سفيان بن موسى [ح] وقرأت عاليًا على أم الحسن التنوخية عن أبي الفضل بن قدامة قال: أنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنا داود بن أحمد أن أبا الفضل الارموي أخبرهم قال: أنا جابر بن يس قال: ثنا عمر الكتاني قال: ثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: ثنا الصلت بن مسعود قال: ثنا سفيان بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من استطاع منكم أن يكوت بالمدينة فليمت بها فإني أشغع لمن مات بها”، هذا حديث حسن أخرجه الهيثم الشاشي في مسنده عن علي بن عبد العزيز عن الرقاشي فوقع لنا بدلًا وعاليًا بدرجة من الطريق الثاني، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأبو يعلى وابن حبان كلهم من طريق هشام الدستوائي عن أيوب قال الترمذي: حسن غريب، وفي الباب عن سبيعة قلت: وقع لنا حديث سبيعة في فوائد الفاكهي وفي جزء بيبى عاليًا وأخرجه ابن منده في المعرفة من حديث سمية البيتية مثل حديث سبيعة، وذكر الشيخ في شرح المهذب الحديث الذي قرأته على أبي اليسر أحمد بن عبد الله بن الصائغ الدمشقي عن أحمد بن علي الهكاري سماعًا قال: أنا أبو الحسن بن أبي بكر الخواص في كتابه قال: أنا أبو الفتح بن نجا قال: أنا الحسين بن علي البُسري قال: أنا أبو محمد عبد الجبار السكري قال: أنا إسماعيل الصفار قال: ثنا العباس بن عبد الله قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: ثما حياة بن شريح عن أبي صخر هو حميد بن زياد عن يزيد بن عبد بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما من أحد يسلّم إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه”. هذا حديث حسن أخرجه أحمد عن المقري والبيهقي عن السكري، فوقع لنا موافقة عالية فيهما، وأخرجه أبو داود عن محمد بن عوف عن المقري فوقع لنا بدلًا عاليًا أنبئت عن الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه شفاء السقام قال: اعتمد جماعة من الأئمة على هذا الحديث في استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعتماد صحيح لأن الزائر إذا سلّم وقع الرد عليه عن قرب وتلك فضيلة مطلوبة.
تنبيه: ذكر الشيخ الموفق ابن قدامة في المغني هذا الحديث وفيه زيادة بعد قوله يسلم علي عند قبري ولم أرها في شيء من طرق هذا الحديث والعلم عند الله تعالى.
قوله في صفة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله. وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب من وجه ءاخر عن أبي هريرة مرفوعًا: “من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ من بعيد علمته” وقد ذكرناه في مسند إلى ءاخره قلت لم أجده مأثورًا بهذا التمام، وقد ورد عن ابن عمر بعضه.
قرأت على الشيخ أبي عبد الله بن قوام عن أبي الحسن بن هلال سماعًا عليه قال: أنا أبو إسحاق بن مضر قال: أنا أبو الحسن الطوسي قال: أنا أبو محمد السيدي قال: أنا أبو عثمان البحيري قال: أنا أبو علي السرخسي قال: أنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أنا أبو مصعب الزهري قال: أنا مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم يدعوا. هذا موقوف صحيح اهـ كلام الحافظ ابن حجر.
ولنذكر ما قال الحافظ الزبيدي في الإتحاف [52] قال: وقد وردت أحاديث في فضل زيارته صلى الله عليه وسلم أورد المصنف –يعني الغزالي- منها ثلاثة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي،، قال العراقي رواه ابن عدي والطبراني والدارقطني والبيهقي وضعفه من حديث ابن عمر اهـ. قلت ورواه البزار وأبو يعلى وابن عدي والدارقطني من طريق حفص بن أبي داود عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر، ومن هذا الوجه رواه البيهقي، ووجه تضعيفه أن راويه حفصًا ضعيف الحديث وإن كان أحمد قال فيه صالح، وأما الطبراني فرواه في الأوسط من طريق الليث ابن بنت الليث بن أبي سليم عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم، وفي هذا الإسناد من لا يعرف. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعًا: “من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي” وكذلك لفظ الدارقطني وأبي الشيخ والطبراني وابن عدي والبيهقي، وزاد ابن الجوزي في مثير الغرام: وصحبني وعن حاطب بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة” أخرجه الدارقطني وابن نافع والبيهقي وأبو بكر الدينوري في المجالسة وابن الجوزي في الموضوعات، وقال ابن حبان في سنده النعمان بن شبل وهو يأتي عن الثقات بالطامات، وقال الدارقطني الطعن في هذا الحديث على ابن ابنه محمد بن مهر بن النعمان على النعمان. وقال صلى الله عليه وسلم: “من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني”. قال العراقي رواه ابن عدي والدارقطني في غرائب مالك، وابن حبان في الضعفاء، والخطيب في الرواة عن مالك من حديث ابن عمر بلفظ: “من حج ولم يزرني فقد جفاني”، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وروى البخاري في تاريخ المدينة من حديث أنس “ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر”. اهـ قلت وحديث ابن عمر رواه أيضًا الديلمي وعبد الواحد التميمي الحافظ في كتاب جواهر الكلام في الحكم والأحكام من كلام سيد الأنام، وقد رد الحافظ السيوطي على ابن الجوزي في إيراده في الموضوعات وقال لم يصب، وحديث أنس أخرجه أبو محمد بن عساكر في فضائل المدينة.
وقال صلى الله عليه وسلم: “من جاءني زائرًا لا يهمه إلا زيارتي كان حقًا علي أن أكون له شفيعًا”. قال العراقي رواه الطبراني من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن. اهـ. قلت: ورواه الدارقطني والخلعي في فوائده بلفظ: “لم تنزعه حاجة إلا زيارتي”. وتصحيح ابن السكن إياه وإيراده له في في أثناء الصحاح له، وكذا صححه عبد الحق في سكوته عنه، والتقي السبكي في رد مسئلة الزيارة لابن تيمية باعتبار مجموع الطرق، وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا سوار بن ميمون أبو الجراح المعبري قال حدثني رجل من ءال عمر عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من زارني لا يهمه إلا زيارتي كنت له شفيعًا أو شهيدًا ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين”. فهذه ثلاثة أحاديث أوردها المصنف. وفي الباب أحاديث أخر منها عن أنس رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة أظلم منها كل شيء ولما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “المدينة بها قبري وبها بيتي وتربتي وحق على كل مسلم زيارتها” أخرجه أبو داود، وعنه أيضًا: “من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة”. أخرجه البيهقي وابن الجوزي في مثير الغرام، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور. حدثنا سعيد بن عثمان الجرجاني حدثنا ابن أبي فديك أخبرني أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس فساقه، وسليمان ضعفه ابن حبان والدارقطني، وعن رجل من ءال حاطب رفعه: “من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة” الحديث أخرجه البيهقي وهو مرسل، والرجل المذكور مجهول، وزاد عبد الواحد التميمي في جواهر الكلام: “من زارني إلى المدينة”.
ثم قال: وعن ابن عباس: “من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتب له حجتان مبرورتان” أخرجه الديلمي، وعن ابن عمر رفعه: “من زار قبري وجبت له شفاعتي” أخرجه الحكيم الترمذي وابن عدي والدارقطني والبيهقي من طريق موسى بن هلال العبدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وموسى قال أبو حاتم: مجهول أي العدالة، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده شيئًا، ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر الضعيف لا المصغر الثقة، وجزم الضياء في الأحكام وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبّر.
وإذا فهمت ذلك فاعلم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهم القربات ويندب أن ينوي الزائر مع التقرب بزيارته صلى الله عليه وسلم التقرب بالمسافرة إلى مسجده الرشيف بالصلاة فيه كيلا تفوته فضيلة شد الرحال، وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن ما علل به وجه الكراهة ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لئلا يقع التشبه بأولئك سدًا للذريعة وحسمًا للباب اهـ. قاله الزبيدي.
وفي كتاب دفع شبه من شبَّه وتمرّد للحُصني ما نصه [53]: قال ابن تيمية: ولا دعاء هناك –أي عند القبر- وقال أيضًا: وأما وقت السلام فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، والحاصل من كلامه أنه لا يُدعى عند القبر بالاتفاق ولا يستقبل القبر عند الدعاء بالإجماع، وأن الحكاية التي وقعت بين مالك وأبي جعفر المنصور كذب. سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا من الفجور الذي لا أعلم أحدًا فاه به ولا رمز إليه من العلماء ولا من غيرهم، أنا قضية مالك مع المنصور فقد ذكرتها في الكلام على التوسل فهي صحيحة بلا نزاع، وأما الدعاء عند القبر فقد ذكره خلق ومنهم الإمام مالك وقد نص على أن يقف عند القبر، ويقف كما يقف الحاج عند البيت للوداع ويدعو، وفيه المبالغة في طول الوقوف والدعاء، وقد ذكره ابن المواز في الموازية فأفاد ذلك أن إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عنده والدعاء عنده من الأمور المعلومة عند مالك، وأن عمل الناس على ذلك قبله وفي زمنه، ولو كان الامر على خلاف ذلك لأنكره فضلًا عن أن يفتي به أو يقرّ عليه، وقال مالك في رواية ابن وهب إذا سلّم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو ويسلّم ولا يمس القبر بيده. وقال أبو عبد الله محمد عبد الله السامري في كتاب المستوعب في باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه: وإذا قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له أن يغتسل لدخوله، ثم يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم رجله اليمنى في الدخول، ثم يأتي حائط القبر فيقف ناحيته ويجعل القبر تلقاء وجهه والقبلة خلف ظهره والمنبر عن يساره، ثم ذكر كيفية السلام والدعاء وأطال، ومنه: اللهم إنك قلن في كتابك لنبيك عليه الصلاة والسلام: {ولو أنَّهُمْ إذ ظَّلموا أنفُسَهُم جاءُوكَ} الآية [سورة النساء/64] وإني قد أتيتك مستغفرًا فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حال حياته، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، وذكر دعاء طويلًا، ثم قال: وإذا أراد الخروج وعاد إلى القبر فودّع اهـ. وهذا أبو عبد الله من أئمة الحنابلة، وكذلك ذكر أبو منصور الكرماني من الحنفية أنه يدعو ويطيل الدعاء عند القبر المكرم، وفي مناسك الإمام أبو زكريا النووي ما نصه: فصل في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كلامًا مطولًا، ثم قال: فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر فاستقبله واستدبر القبلة على نحو أربعة أذرع من جدار القبر وسلم مقتصدًا لا يرفع صوته اهـ.
وقال الحصني: وذكره –أي السفر لزيارة قبر الرسول- الإمام أبو بكر أحمد بن النبيل في مناسك لطيفة جرّدها من الأسانيد والتزم فيها الثبوت، ولفظه وكان عمر بن عبد العزيز يبعث بالرسول قاصدًا من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم يرجع. وهذا الإمام أبو بكر قديم توفي في سنة سبع وثمانين ومائتين.
وذكر السير إليه –أي إلى قبر النبي- كثير من أصحاب الشافعي من جملتهم السيد الجليل أبو زكريا يحيى النووي قدّس الله روحه قال في كتابه المناسك وغيرها: فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك على طريقه أم لا فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهمّ القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات اهـ.
ثم قال: قالت الحنفية إن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المندوبات والمستحبات. وممن صرح بذلك الإمام أبو منصور محمد الكرماني في مناسكه، والإمام عبد الله بن محمود في شرح المختار، وقال الإمام أبو العباس السروجي: وإذا انصرف الحاج من مكة شرّفها الله تعالى فليتوجه إلى طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره فإنها من أنجح المساعي، وكلامهم في ذلك يطول.
وقال ابن الخطاب محفوظ الكلواذي الحنبلي من أئمة الحنابلة في كتابه الهداية في ءاخر باب صفة الحج: استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وصاحبيه اهـ. وقال الإمام أحمد بن حمدان في الرعاية الكبرى: ويستحب لمن فرغ من نسكه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، وذلك بعد فراغ الحج وإن شاء قبله، وذكر نحو ذلك غيرهم ومنهم الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه مثير الغرام وعقد له بابًا في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام.
ومن ذلك ما في كتاب تهذيب الطالب لعبد الحق الصقلي عن أبي عمران المالكي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وقال عبد الحق في هذا الكتاب: رأيت في بعض المسائل التي سئل عنها أبو محمد بن أبي زيد قيل له في رجل استؤجر بمال ليحج به وشرطوا عليه الزيارة فلم يستطع تلك السنة أن يزور لعذر منه من ذلك فقال: يردّ من الاجرة بقدر مسافة الزيارة وهي مسئلة حسنة.
وقال العبدي المالكي في شرح الرسالة: إن المشي إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المشي إلى الكعبة وبيت المقدس، وصدق وأجاد رضي الله عنه، وفي بعض النقول الإجماع على طلب الزيارة بعدت المسافة أو قصرت، وعمل الناس على ذلك في جميع الأعصار من جميع الأقطار، فكيف يحلّ لأحد أن يبدّعهم بالقول الزور ويضلل أئمة أمة المختار! بل من المصائب العظيمة أن يوقع وفد الله تعالى في جريمة عظيمة وهي عصيانهم بشد رحالهم لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم عقب ما رجوه من المغفرة وبتركهم الصلاة التي هي أحد أركان الدين لأنهم إذا لم يجز لهم القصر وقصروا فقد تركوا الصلاة عامدين ومن تركها متعمدًا قتل إما كفرًا وإما حدًا، ولا يصدر هذا إلا ممن هو شديد العداوة لوفد الله تعالى ولحبيبهم الذين يرتجون بزيارتهم له استحقاق الشفاعة التي بها نجاتهم.
ثم قال: وقول ابن تيمية إن ما ذكروه من الاحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بل هي موضوعة، لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئًا منها أعوذ بالله من مكر الله عز وجل. انظر أدام الله لك الهداية وحماك من الغواية إلى فجور هذا الخبيث كيف جعل الأحاديث المروية في زيارة قبر خير البرية كلها ضعيفة ثم أردف ذلك بقوله باتفاق أهل العلم بالحديث، ولم يجعل الأئمة الذين أذكرهم من أهل الحديث، والعجب أنه روى عنهم في مواضع عديدة من كتبه.
ثم إنه لم تخمد نار خبثه بما ذكره من الفجور حتى أردف ذلك بأن الأحاديث المروية في زيارة القبر المكرم موضوعة، وهذا شيء لم يُرَ أحد من علماء المسلمين ولا من عوامهم فاه به ولا رمز إليه لا من في عصره ولا من قبله، قاتله الله، ولقد أسفرت هذه القضية عن زندقته بتجرئه على الإفك على العلماء وعلى أنه لا يعتقد حرمة الكذب والفجور ولا يبالي بما يقول وإن كان فيه عظائم الأمور، وإذا عرفت هذا فينبغي أيها المؤمن الخالي من البدعة والهوى أن لا تقلده فيما ينقله ولا فيما يقوله، بل تفحص عن ذلك واسأل غير أتباعه ممن له رتبة في العلوم وإلا هلكت كما هلك هو وأتباعه. وقد خرّج هذا الحديث أبو اليمن في كتابه إتحاف الزائر وأطراف المغنم للسائر، وخرّجه الحافظ أبن عساكر في تاريخه في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بعد وفاته اهـ. كلام الحصني.
علم مما مرّ أن مصيبة هؤلاء المكفرين للمتوسلين والمستغيثين بالأنبياء والأولياء بعد موتهم وفي حياتهم في غير حضورهم، سوء فهمهم للآيات والأحاديث التي يستدلون بها على ذلك، ظنوا أن معنى العبادة هو النداء والاستعانة والخوف والرجاء والاستغاثة، فهذه في ظنهم هي العبادة التي من صرفها لغير الله يكون مشركًا، وكذلك ظنوا أن من طلب من غير الله ما لم تجرِ به العادة صار مشركًا.
كيف ساغ لهم ذلك وقد ثبت أن الحارث بن حسان البكري رضي الله عنه قال: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد… الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الحافظ ابن حجر، وتمامه كما في مسند أحمد عن الحارث بن يزيد البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع [54] بها، فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي إليه، قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاصّ بأهله، وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس، قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجهًا [55]، قال: فجلست، قال: فدخل منزله أو قال: رحله، فاستأذنت عليه، فأذن لي، فدخلت فسلمت فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء، قال فقلت: نعم، قال: وكانت لنا الدّبرة عليهم، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي الباب، فأذن لها فدخلت فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزًا فاجعل الدهناء، فحميت العجوز واستوفزت قالت: يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك، قال قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملتُ حتفها، حملتُ هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصمًا، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه، قلت: إنّ عادًا قحطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال له قيل، فمرّ بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرًا يسقيه خمرًا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان، فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، الله اسق عادًا ما كنت تسقيه، فمرت به سحابات سود فنودي منها: اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادًا رمددًا لا تبقي من عاد أحدًا، قال: عما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا، قال ابن وائل: وصدق، قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدًا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد اهـ.
والدليل فيه أن الرسول لم يقل للحارث أشركت لقولك “ورسوله”، حيث استعذت بي [56].
وثبت أيضًا أن ابن عباس روى عن النبي أنه قال: “إنّ لله ملائكة سوى الحفظة سياحين يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة في فلاة فليناد: يا عباد الله أعينوا” –رواه الحافظ ابن حجر في الأمالي وحسنه-.
فلما ساء فهمهم جعلوا هذه الأشياء عبادة لغير الله لمجرد ألفاظها، فكفّروا المسلمين من أجل أمر اتفق السلف والخلف على جوازه، وذلك دليل على أنهم لم يفهموا معنى العبادة الواردة في القرءان على حسب مفهوم اللغة العربية، وقد بيّنها علماء اللغة بيانًا لا يبقى معه لبس، وقد مرّ تعريفهم للعبادة بأنها غاية التذلل، وكيف حكموا بأن ما لم تجر به العادة شرك وجعلوا ذلك قاعدة وقد طلب بعض الصحابة وهو ربيعة بن كعب الأسلمي من رسول الله أن يكون رفيقه في الجنة، فلم ينكر عليه بل قال له من باب التواضه: “أو غير ذلك”، فقال الصحابي: هو ذاك، فقال له: “أعِنّي على نفسك بكثرة السجود” –رواه مسلم-.
وقد صحح ابن حبان والحاكم والهيثمي أن امرأة من بني إسرائيل سألت موسى أن يعطيها حكمها فقال: ما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة –فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها-.
ولفظ الحديث كما في المطالب العالية [57] عن أبي موسى قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فأكرمه فقال له: “ائتنا”، فأتاه فقال: “سل حاجتك”، فقال: ناقة نركبها، وأعنز يحلبها أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟” فسألوه فقال: “إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر، ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت، أخذ علينا موثقًا من الله أن لا نخرج من مصر، حتى ننقل عظامه معنا، قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز من بني إسرائيل، فبعث إليها، فأتته، فقال: دلوني على قبر يوسف، قالت: حتى تعطيني حكمي، قال: ما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة، فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت: أنضِبوا هذا الماء، فأنضبوه قالت: احتفروا، فحفروا واستخرجوا عظام يوسف، فلما أقلّوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار”.
ولا ينافي هذا حياة الانبياء في قبورهم، لأن هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وهو من أنواع المجاز المشهورة كما قال ابن قيس الرقيات في طلحة الطلحات قال:
رحم الله أعظمًا دفنوها *** بسجستان طلحة الطلحات [58]
ومعلوم أن ابن قيس لا يقصد أنهم دفنوا الأعظم المتجرد عن الجلد واللحم، ومن الشائع المشهور عند العرب قولهم وجه فلان وجه خير وهم يقصدون بالوجه ذاته، فتبين أن ذكر العظام في قصة يوسف المراد به جملة الجسد فلا ينافي معناه حديث: “الأنبياء أحياء في قبورهم”.
وإنما يكون شركًا طلب ما انفرد به الله تعالى كطلب خلق شيء أي إحداثه من العدم، وطلب مغفرة الذنوب، قال تعالى: {هل من خالقٍ غيرُ الله} [سورة غافر/3] وقال: {ومَن يغفرُ الذنوبَ إلا الله} [سورة ءال عمران/135]. وقد قال جبريل لمريم: {لأهبَ لكِ غُلامًا زكيًّا} [سورة مريم/19] فواهب الغلام الذي هو عيسى لمريم في الحقيقة هو الله، ولكن الله جعل جبريل سببًا، فأضاف جبريل هذه الهبة إلى نفسه. وقصة جبريل هذه يعلم منها عظم شطط هؤلاء في تكفير المتوسلين والمستغيثين لمجرد قول أحدهم: يا رسول الله ضاقت حيلتي أغثني يا رسول الله، وما شابه ذلك من العبارات التي هي غاية التذلل، بل يعنون أنه سبب لنيل المقصود والبركة من الله، ولا يفهمون من الواسطة إلى معنى السببية، وإن أطلق بعضهم في ذلك لفظ الواسطة فهذا ما يعنونه. وقد أجرى الله العادة بربط المسببات بالأسباب، فالله تبارك وتعالى كان قادرًا على أن يعطي مريم ذلك الغلام الزكي من دون أن يكون لجبريل سببية في ذلك.
فكيف يسوغ تكفير المسلم لمجرد أنه قال: إن النبي والوبي واسطة بمعنى السبب، إنما الشرك هو إثبات الواسطة بمعنى أن شيئًا يعين الله أو أن الله سبحانه لا يستطيع أن يحصّل ذاك الشيء استقلالًا إلا بواسطة النبي أو الولي، فهذا هو الشرك لو كانوا يفهمون.
فائدة:
فيما تأكيد ما سبق ذكره أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي بعد موته أمرًا جائزًا لا بأس به.
ذكر الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب “الوفا بأحوال المصطفى” –ذكره الحافظ الضياء المقدسي- ما نصه: “عن أبي بكر المنقري قال: كنت انا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله وكنا في حالة فأثر فينا الجوع وواصلنا ذلك اليوم [أي ما أكلنا]، فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت: يا رسول الله الجوع الجوع، وانصرفت. فقال لي أبو القاسم: اجلس فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ، والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب عَلوي [60] فدقّ ففتحنا له فإذا معه غلامان مع كل واحد زنبيل [61] فيه شيء كثير فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم أشكوتم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأمرني أن أحمل بشيء إليكم” اهـ.
ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول أمرًا جائزًا حسنًا ثم نقلها عدد من العلماء في مؤلفاتهم منهم الحنابلة وغيرهم، فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون بل من أجلاء الموحدين، وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية قد أشركوا، لأن من استحسن الشرك يكفر، فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدًا واسعًا، فليعدوا جوابًا إذا سئلوا يوم العرض.
ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وهو الذي قال فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه، قال ما نصه [62]:
أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين الإستراباذي. قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي قال: سمعت الحسن بن إبراهيم أبا علي الخلال يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري قال: أنبأنا محمد بن الحسين السلمي قال: سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا علي الصفار يقول: سمعت إبراهيم الحربي يقول: قبر معروف الترياق المجرب –أي أنه يقصد للدعاء عنده فتقضى الحاجات-.
أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي قال: نبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد الزهري قال: سمعت أبي يقول: قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج، ويقال: إنه من قرأ عنده مائة مرة: {قل هو الله أحد} [سورة الإخلاص/1] وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته.
حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن جُميع يقول: سمعت أبا عبد الله بن المحاملي يقول: أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة، ما قصده مهموم إلا فرّج الله همه.
أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري قال: أنبأنا عمر بن إبراهيم المقري قال: نبأنا مكرم بن أحمد قال: نبأنا عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال: نبأنا علي بن ميمون قال: سمعت الشافعي يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم –يعني زائرًا- فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عني حتى تقضى.
ومقبرة باب البردان، فيها أيضًا جماعة من أهل الفضل، وعند المصلى المرسوم بصلاة العيد كان قبر يعرف بقبر النذور، ويقال: إن المدفون فيه رجل من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتبرك الناس بزيارته، ويقصده ذو الحاجة منهم لقضاء حاجته.
حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: حدثني أبي قال: كنت جالسًا بحضرة عضد الدولة ونحن مخيمون بالقرب من مصلى الأعياد في الجانب الشرقي من مدينة السلام نريد الخروج معه إلى همذان في أول يوم نزل المعسكر، فوقع طرفه على البناء الذي على قبر النذور فقال لي: ما هذا البناء؟ فقلت: هذا مشهد النذور، ولم أقل قبر لعلمي بطيَرته من دون هذا، واستحسن اللفظة، وقال: قد علمت أنه قبر النذور، وإنما أردت شرح أمره، فقلت: هذا يقال إنه قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ويقال: إنه قبر عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وإن بعض الخلفاء أراد قتله خفيًا، فجعلت له هناك زبية وسيّر عليها وهو لا يعلم، فوقع فيها وهيل عليه التراب حيًا، وإنما شهر بقبر النذور لأنه ما يكاد ينذر له نذر إلا صح وبلغ الناذر ما يريد ولزمه الوفاء بالنذر، وأنا أحد من نذر له مرارًا لا احصيها كثرة نذورًا على أمور متعذرة، فبلغتها ولزمني النذر فوفيت به، فلم يتقبل هذا القول وتكلم بما دل أن هذا إنما يقع منه اليسير اتفاقًا، فيتسوق العوام بأضعافه، ويسيرون الأحاديث الباطلة فيه، فأمسكت، فلما كان بعد أيام يسيرة ونحن معسكرون في موضعنا استدعاني في غدوة يوم وقال: اركب معي إلى مشهد النذور، فركب وركب في نفر من حاشيته إلى أن جئت به إلى الموضع، فدخله وزار القبر وصلى عنده ركعتين سجد بعدهما سجدة أطال فيها المناجاة بما لم يسمعه أحد، ثم ركبنا معه إلى خيمته وأقمنا أيامًا، ثم رحل ورحلنا معه يريد همذان، فبلغناها وأقمنا فيها معه شهورًا، فلما كان بعد ذلك استدعاني وقال لي: ألست تذكر ما حدثتني به في أمر مشهد النذور ببغداد، فقلت: بلى، فقال: إني خاطبتك في معناه بدون ما كان في نفسي اعتمادًا لإحسان عشرتك، والذي كان في نفسي في الحقيقة أن جميع ما يقال فيه كذب، فلما كان بعد ذلك بمديدة طرقني أمر خشيت أن يقع ويتمّ، وأعملت فكري في الاحتيال لزواله ولو بجميع ما في بيوت أموالي وسائر عساكري، فلم أجد لذلك فيه مذهبًا، فذكرت ما أخبرتني به في النذر لمقبره النذور، فقلت: لم لا أجرب ذلك، فنذرت إن كفاني الله تعالى ذلك الأمر أن أحمل إلى صندوق هذا المشهد عشرة ءالاف درهم صحاحًا، فما كان اليوم جاؤتني الأخبار بكفايتي ذلك الأمر، فتقدمت إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف –يعني كاتبه- أن يكتب إلى أبي الريان وكان خليفته ببغداد يحملها إلى المشهد، ثم التفت إلى عبد العزيز وكان حاضرًا، فقال له عبد العزيز: قد كتبت بذلك ونفذ الكتاب اهـ.
وليعلم أننا لا نقول بتصحيح ما يكون من النذور لقبور الأولياء والمشايخ على اعتقاد أن تلك الأماكن لها خصوصية في جلب منفعة أو دفع مضرة من غير أن يقصدوا التقرب إلى الله بالتصدق عن أصحابها ليقضي الله لهم حاجاتهم، بل نقول كما قال الأذرعي رحمه الله: إن كثيرًا من نذور العوام للمشاهد باطلة محرمة لأنهم يقصدن أن تلك الأماكن بخصوصية لها تجلب المنافع وتدفع المضار. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقال نور الدين علي القاري في شرح المشكاة ما نصه: قال شيخ مشايخنا علامة العلماء المتبحرين شمس الدين الجزري في مقدمة شرحه للمصابيح: المسمى بتصحيح المصابيح: إني زرت قبره بنيسابور [يعني مسلم بن الحجاج القشيري] وقرأت بعض صحيحه على سبيل التيمّن والتبرك عند قبره، ورأيت ءاثار البركة ورجاء الإجابة في تبرته اهـ.
هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبثون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الامة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، وأما من عاصروه فمنهم المحدث الحافظ تقي الدين السبكي وغيره فاما فيما قبل ابن تيمية فالحافظ عبد الغافر الفارسي والحافظ الخطيب البغدادي الذي ذكر المحدثون في كتب المصطلح التنويه به وعدّ أحد المشاهير البارزين في الحديث، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه، وكذلك من جاءوا بعده من الحفاظ كالحافظ محمد مرتضى الزبيدي، فعلى قوله وقول أتباعه أتباع محمد بن عبد الوهاب يلزم أن يكون جمهور الأمة الذين هم مئات الملايين على ضلال ويكون هو والشرذمة التي اتبعته على هدى، وقد ثبت أن جمهور الأمة لا يضلون، ما دل على ذلك حديث أبي داود في افتراق الامة إلى ثلاث وسبعين فرقة حيث قال: “ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة” أي الجمهور، فمما لا شك فيه أن بعض الامة ضلوا وهؤلاء البعض لو تعددت أسامي فرقهم إلى هذا العدد الاثنين والسبعين فهم شرذمة بالنسبة للذين هم هم محفوظون من الضلال في العقيدة، وهذا الي عناه الرسول لم يعن كثرة التقصير في الأعمال والانغمار في الغفلة، وقد صحّ موقوفًا على أبي مسعود الصحابي الجليل: “إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة”، صححه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين أشاعرة وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من المتريدية، والأشاعرة والماتريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع، فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب والجزائر وتونس وتركيا وأندونيسيا والباكستان والهند وأهل أفريقيا السوداء ودول جنوب أفريقيا وأما المشبهة والوهابية الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية بدعة تكفير زوّار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم بالمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الوشل [63] إلى البحر، فيا سخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة واتباعهم منذ أربعة عشر قرنًا كانوا على ضلال، وقد صرّح هؤلاء بهذه المقالة الشنيعة: إن الناس فارقوا التوحيد منذ ستمائة سنة، كما ذكر ذلك الشيخ أحمد زيني دحلان مفتي مكة في أواخر الدولة العثمانية كما تقدم.
وفي كتاب المعيار لأبي العباس أحمد بن يحيى الوانشريسي المتوفى سنة تسعمائة وأربع عشرة المالكي ما نصه [64]: وسئل بعض القَرويين عمّن نذر زيارة قبر رجل صالح أو حي فأجاب: زيارة أو رباط أو غير ذلك من الطاعة غير الصلاة فيلزمه الإتيان إليه، وحديث: “لا تُعمَل المطي” [65] مخصوص بالصلاة، وأما زيارة الأحياء من الإخوان والمشيخة ونذر ذلك والرباط ونحوه فلا خلاف في ذلك، والسنة تهدي إليه من زيارة الأخ في الله والرباط في الأماكن التي يرابط بها. وتوقف بعض الناس في زيارة القبور وءاثار الصالحين، ولا يتوقف في ذلك لأنه من العبادات غير الصلاة، ولأنه من باب الزيارة والتذكير لقوله صلى الله عليه وسلم: “زوروا القبور فإنها تذكركم الموت” [66]، وكان صلى الله عليه وسلم يأتي حراء وهو بمكة ويأتي قُباء وهو بالمدينة، والخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واقتفاء ءاثاره قولًا وفعلًا لا سيما فيمن ظهرت الطاعة فيه اهـ.
وفي ضمن كلام الوانشريسي أن عمل المسلمين جرى على التبرك بزيارة القبور المباركة عكس عقيدة التيميين، فتبين بذلك أنهم شاذون عن الامة في نحلتهم المعروفة وهي محاربة التوسل بالرسول وغيره من الأنبياء والأولياء ومحاربة زيارة القبور بقصد التبرك. قد أسفر الصبح لذي عينين.
ومما يثبت أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم لم يكترثوا بشذوذ ابن تيمية من تحريم التوسل بالرسول بعد وفاته أن الحافظ ابن حجر العسقلاني توسل بالنبي في قصائده المسماة بالنيرات السبع، وكذلك شيخه زين الدين العراقي في ءاخر منظومته في تفسير مفردات القرءان، ولم يزل ذلك دأب العلماء السلف والخلف، ولم يتحاشَ ذلك إلا من فتن ببدعة ابن تيمية تلك البدعة الكبرى تحريمه التوسل بالنبي الذي ليس في حياته ولا في حضوره.
وإليك أيها المطالع مقتطفات من قصائد الحافظ التي سماها النيرات السبع التي تتضمن التوسل بالنبي ويرى فيها قصده عند الشدة وسؤال الله به قال:
يا سيّدَ الرُّسْلِ الذي منهاجُهُ *** حاوٍ كمالَ الفضلِ والتهذيبِ
إلى أن قال:
فاشفعْ لمادِحِكَ الذي بكَ يتَّقي *** أهوالَ يوم الدين والتعذيبِ
فلأحمدَ بنِ عليّ الأثريّ في *** مأهولِ مَدحِكَ نظمُ كلّ غريبِ
قدْ صحَّ أن ضناهُ زادَ وذنبهُ *** أصلُ السقامِ وأنتَ خيرُ طبيبِ
ثم قال في قصيدة أخرى:
يا سيدي يا رسول اللهِ قد شَرُفَتْ *** قصائدي بمديحٍ فيكَ قد رُصِفا
إلى أن قال:
ببابِ جودِكَ عبدٌ مذنبٌ كَلِفٌ *** يا احسنَ الناسِ وجهًا مُشرِقًا وَقَفا
بكُمْ تَوَسَّلَ يرجو العفوَ عن زللٍ *** مِنْ خوفِهِ جَفْنُهُ الهامي لقدْ ذَرَفا
وإنْ يكُنْ يُعزى إلى حجرٍ *** فطالما فاضَ عذبًا طيبًا وصفا
ثم قال في قصيدة أخرى:
إصدحْ بمدحِ المصطفى واصدَعْ بهِ *** قلبَ الحسودِ ولا تخَفْ تفنيدا
واقصِدْ لهُ واسألْ لهِ تُعْطَ المُنى *** وتعيشُ مهما عِشْتَ فيه سعيدا
خيرُ الأنام مَنْ لجا لجنا بهِ *** لا بِدْعَ أن أضحى به مَسْعودا
ثم قال في قصيدة أخرى:
فما تبلُغُ الأشعارُ فيهِ ومدحُهُ *** بهِ ناطقٌ نصُّ الكتابِ وناقلُ
إلى أن قال:
ولي إنْ توسَّلتُ الهناءُ بمدحهِ *** لأنّيَ مُستجدٍ هناكَ وسائلُ
ثم قال في قصيدة أخرى:
فإنْ أحْزَنْ فمدحُكُ لي لي سروري *** وإنْ أقْنَطْ فحَمْدُكَ لي رجائي
ثم قال في قصيدة أخرى:
نبيُّ براهُ اللهُ أشرفَ خلقِهِ *** وأسماهُ إذْ سمّاهُ في الذكرِ أحمدا
فرجٌ نداهُ أنه الغيثُ في الندى *** وخَفْ مِنْ سَطاهُ إنهُ الليثُ في العِدا
إلى أن قال:
حليمٌ فقيسٌ في النَّديّ مجهَّلٌ *** كريمٌ ودَعْ ذكرَ ابنِ مامةَ في الندى
فكمْ حَمَدَتْ منهُ الفوارسُ صوْلَةً *** وعادَ فكانَ العَودُ أحمى وأحمدا
ثم قال في قصيدة أخرى:
وإن قَنَطَتْ مِنَ العصيانِ نفْسٌ *** فبابُ محمدٍ بابُ الرجاءِ
وقال ابن الحاج المالكي المعروف بإنكاره للبدع في كتابه المدخل [67] ما نصه: فالتوسل به عليه الصلاة والسلام هو محل حط أحمال الأوزار وأثقال الذنوب والخطايا لأن بركة شفاعته عليه الصلاة والسلام وعظمها عند ربه لا يتعاظمها ذنب، إذ إنها أعظم من الجميع، فليستبشر من زاره ويلجأ إلى الله تعالى بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام من لم يزره، اللهم لا تحرمنا من شفاعته بحرمته عندك ءامين يا رب العالمين ومن اعتقد خلاف هذا فهو المحروم ألم يسمع قول الله عز وجل: {ولو أنَّهُم إذ ظلموا أنفسهُم جاءوكَ فاستغفروا اللهَ واستغفرَ لهم الرسولُ لَوَجدوا اللهَ توابًا رحيمًا} [سورة النساء/64]. فمن جاءه ووقف ببابه وتوسل به وجد الله توابًا رحيمًا، لأن الله عز وجل منزه عن خلف الميعاد وقد وعد سبحانه وتعالى بالتوبة لمن جاءه ووقف ببابه وسأله واستغفر ربه، فهذا لا يشك فيه ولا يرتاب إلا جاحد للدين معاند لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الحرمان. اهـ كلام أبي عبد الله بن الحاج.
* ثم إن من مواطن تشويشهم على المسلمين إهداء القراءة للأموات ويكفي في إثبات ذلك بالاستدلال حديث البخاري أنه عليه السلام قال لعائشة: “لو كان ذاكِ وأنا حي لاستغفرت لكِ ودعوت لك”. محل الشاهد في هذا الحديث قوله: “ودعوت لك” فإن هذه الكلمة تشمل الدعاء بأنواعه، فدخل في ذلك دعاء الرجل بعد قراءة شيء من القرءان لإيصال الثواب للميت بنحو قول: اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، وما شهر من خلاف الشافعي من قول: إن القراءة لا تصل إلى الميت، فهو محمول على القراءة التي تكون بلا دعاء بالإيصال وبغير ما إذا كانت القراءة على القبر، فإن الشافعي أقرّ ذلك.
قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء [68] ما نصه: قال السيوطي في شرح الصدور: وأما قراءة القرءان على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم، قال الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال لا بأس به، وقال النووي في شرح المهذب: يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسّر من القرءان ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب، زاد في موضع ءاخر: وإن ختموا القرءان على القبر كان أفضل. انتهى.
وقد سئل الشمس محمد بن علي بن محمد بن عيسى العسقلاني الكناني السمنودي الشافعي –عرف بابن القطان المتوفى في سنة 813 وهو من مشايخ الحافظ ابن حجر- عن مسائل فأجاب، ومنها: وهي يصل ثواب القراءة للميت أم لا؟ فأجاب عنها في رسالة سمّاها القول بالإحسان العميم في انتفاع الميت بالقرءان العظيم، وأنا أذكر منها هنا ما يليق بالمقام مع الاختصار، قال رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في ثواب القراءة للميت فذهب الأكثرون إلى المنع وهو المشهور من مذهب الشافعي ومالك ونقل عن جماعة من الحنفية، وقال كثيرون منهم يصل وبه قال الإمام أحمد بعد أن قال القراءة على القبر بدعة، بل نقل عنه أنه يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج وصوم واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك، ونقل ذلك عن جماعة من السلف، ونقل عن الشافعي انتفاع الميت بالقراءة على قبره، واختاره شيخنا شهاب الدين ابن عقيل، وتواتر أن الشافعي زار الليث بن سعد وأثنى عليه خيرًا وقرأ عنده ختمة وقال أرجو أن تدوم فكان الأمر كذلك، وقد أفتى القاضي حسين بأن الاستئجار للقراءة على رأس القبر جائز كالاستئجار للأذان وتعليم القرءان، قال النووي في زيادات الروضة: ظاهر كلامه صحة الإجارة مطلقًا وهو المختار فإن موضع القراءة موضع بركة وتنزل الرحمة وهذا مقصود ينفع الميت. وقال الرافعي وتبعه النووي: عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة فيجب عود المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته، لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ الغير له، ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة أقرب إجابة وأكثر بركة، وقال في كتاب الوصية: الذي يعتاد من قراءة القرءان على رأس القبر قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين في عود فائدتها إلى الميت، وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث وهو أن الميت كالحي الحاضر فيرجى له الرحمة ووصول البركة إذا أهدي الثواب إلى القارئ، وعبارة الروضة إذا أوصل الثواب إلى القارئ. انتهى.
وعن القاضي أبي الطيب الثواب للقارئ والميت كالحاضر فترجى له الرحمة والبركة، وقال عبد الكريم الشالوسي: القارئ إن نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه إذ جعل ذلك قبل حصوله وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير، وإن قرأ ثم جعل ما حصل من الثواب للميت ينفعه إذ قد جعل من الأجر لغيره والميت يؤجر بدعاء الغير، وقال القرطبي: وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرءان على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين ثم غرس على قبر نصفًا وعلى قبر نصفًا وقال: “لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا” رواه الشيخان، قال ويستفاد من هذا غرسُ الأشجار وقراءة القرءان على القبور، وإذا خفف عنهم بالاشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرءان، وقال النووي استحب العلماء قراءة القرءان عند القبر واستأنسوا لذلك بحديث الجريدتين وقالوا: إذا وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما حال رطوبتهما فانتفاع الميت بقراءة القرءان عند قبره أولى، فإن قراءة القرءان من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود، وقد نفع القرءان بعض من حصل له ضرر في حال الحياة فالميت كذلك، قال ابن الرفعة: الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرءان إذا قُصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه، وأقرّ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: “وما يدريك أنها رقية”، وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى لأن الميت يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع من الحي، نعم يبقى النظر في أن ما عدا الفاتحة من القرءان الكريم إذا قرئ وقصد به ذلك هل يلتحق به. انتهى. نعم يلتحق به، فروى ابن السني من حديث ابن مسعود أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما قرأت في أذنه”، قال: قرأت: {أفَحَسِبْتُمْ أنَّما خَلَقْناكُم عَبَثًا} [سورة المؤمنون/115] حتى فرغت من ءاخر السورة، فقال صلى الله عليه وسلم: “لو أن رجلًا قرأ بها على جبل لزال”، ومثل ذلك ما جاء به في القراءة بالمعوذتين والإخلاص وغير ذلك، وفي الرقية بالفاتحة دليل على صحة الإجارة والجعالة لينتفع بها الحي فكذلك الميت.
ومما يشهد لنفع الميت بقراءة غيره حديث معقل بن يسار: “اقرءوا على موتاكم” رواه ابو داود، وحديث: “اقرءوا يس على موتاكم” رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان، وحدث: “يس ثلث القرءان لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، فاقرءواها على موتاكم” رواه أحمد. وأوّل جماعة من التابعين القراءة للميت بالمحتضر والتأويل خلاف الظاهر، ثم يقال عليه إذا انتفع المحتضر بقراءة يس وليس من سعيه فالميت كذلك والميت كالحي الحاضر يسمع كالحي الحاضر كما ثبت في الحديث. انتهى ما نقلته من كلام ابن القطان.
وروي عن علي بن موسى الحداد قال: كنت مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي -فيه لين، وقال أبو داود ضعيف روى له البخاري في خبر القراءة خلف الإمام مات سنة سبع وثلاثين ومائتين- معنا فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة على القبر بدعة فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي –أبي إسماعيل الكلبي مولاهم صدوق مات سنة مائتين بحلب روى له الجماعة- فقال: ثقة قال: هل كتبت عنه شيئًا، قال: نعم، قال: أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج –نزيل حلب مقبول روى له الترمذي عن أبيه العلاء بن اللجلاج الشامي، يقال إنه أخو خالد ثقة، روى له الترمذي ولأبيه اللجلاج صحبة عاش مائة وعشرين، خمسين في الجاهلية وسبعين في الإسلام، قال أبو الحسن بن إسماعيل اللجلاج والد العلاء غطفاني، واللجلاج والد خالد عامري- أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يوصي بذلك، فقال له أحمد: فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ، وهكذا أورده القرطبي في التذكرة، وعند الطبراني من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج قال: قال لي أبي: يا بني إذا وضعتني في لحدي فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، ثم سن عليّ التراب سنًّا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، هكذا هو عند الطبراني وكأنه سقط منه: فإني سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحبة للجلاج لا للعلاء، وأما قول ابن عمر فقد روي مرفوعًا رواه البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة”، ورواه الطبراني كذلك إلا أنه قال: “عند رأسه بفاتحة الكتاب” والباقي سواء.
وقال احمد بن محمد المروذي [69]: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم، كذا أورده عبد الحق الأزدي في كتاب العاقبة عن أبي بكر أحمد بن محمد المروذي على الصواب، وروى النسائي والرافعي في تاريخه وأبو محمد السمرقندي في فضائل سورة الإخلاص من حديث علي: من مرّ على المقابر وقرأ {قل هوَ اللهُ أحد} [سورة الإخلاص/1] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر عدد الأموات، قال الشمس بن القطان ولقد حكي لي من أثق به من أهل الخير أنه مر بقبور فقرأ {قل هو الله أحد} وأهدى ثوابها لهم، فرأى واحدًا منهم في المنام وأخبره بأن الله تعالى غفر له ولسائر القبور فخصه ثواب رأس واو من سورة {قل هو الله أحد}، وتقسم الباقون باقيها ببركة سورة {قل هو الله أحد}.
وفي العاقبة لعبد الحق قال: حدثني أبو الوليد إسماعيل بن أحمد عرف بابن أفريد وكان هو وأبوه صالحين معروفين قال لي أبو الوليد: مات أبي رحمة الله عليه فحدثني بعض إخوانه ممن يوثق بحديثه نسيت أنا اسمه، قال لي: زرت قبر أبيك فقرأت عليه حزبًا من القرءان ثم قلت: يا فلان هذا قد أهديته لك فماذا لي، قال: فهبّت علي نفحة مسكٍ غشيتني وأقامت معي ساعة ثم انصرفت وهي معي فما فارقتني إلا وقد مشيت نحو نصف ساعة.
وقال الحافظ ابن رجب: روى جعفر الخلدي قال: حدثنا العباس بن يعقوب بن صالح الانباري سمعت أبي يقول: رأى بعض الصالحين أباه في النوم فقال له: يا بني لم قطعتم هديتكم عنا، قال: يا أبت وهل تعرف الاموات هدية الأحياء، قال: يا بني لولا الأحياء لهلكت الأموات.
وروى ابن النجار في تاريخه عن مالك بن دينار قال: دخلت المقبرة ليلة الجمعة فإذا أنا بنور مشرق فيها فقلت: لا إله إلا الله نرى أن الله عز وجل قد غفر لأهل المقابر، فإذا أنا بهاتف يهتف من البعد وهو يقول: يا مالك بن دينار هذه هدية المؤمنين إلى إخوانهم من أهل المقابر، قلت: بالذي أنطقك إلا خبرتني ما هو، قال: رجل من المؤمنين قام في هذه الليلة فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين وقرأ فيهما فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقال: اللهم إني قد وهبت ثوابها لأهل المقابر من المؤمنين، فأدخل الله علينا الضياء والنور والفسحة والسرور في المشرق والمغرب، قال مالك فلم أزل أقرؤها في كل جمعة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي يقول لي: يا مالك قد غفر الله لك بعدد النور الذي أهديته إلى أمتي ولك ثواب ذلك، ثم قال لي: وبنى الله لك بيتًا في الجنة في قصر يقال له المنيف، قلت: وما المنيف قال المطل على أهل الجنة.
وقال السيوطي في شرح الصدور فصل في قراءة القرءان للميت أو على القبر: اختلف في وصول ثواب القراءة للميت فجمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول، وخالف في ذلك إمامنا الشافعي رضي الله عنه مستدلًا بقوله تعالى: {وأن ليسَ للإنسانِ إلا ما سعى} [سورة النجم/39] وأجاب الأولون عن الآية بوجوه: أحدها: أنها منسوخة بقوله: {والذينَ ءامنوا واتَّبَعَتْهُم ذُرِّيَّتُهُم بإيمانٍ} [سورة الطور/21] الآية أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء، والثاني: أنها خاصة بقوم إبراهيم وموسى عليهما السلام، فأما هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها، الثالث: أن المراد بالإنسان هنا هو الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعي له قاله الربيع بن أنس، الرابع: ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل، فأما من باب الفضل فجائز أن يزيده الله ما شاء قاله الحسين بن الفضل، الخامس: أن اللام بمعنى على أي ليس على الإنسان إلا ما سعى قلت وقد أورد ابن القطان في الرسالة المذكورة هذه الأجوبة وقال: القول بالنسخ روي عن ابن عباس، قال: فجعل الولد والطفل في ميزان أبيه ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء بدليل قوله تعالى: {ءاباؤُكُم وأبناؤُكم لا تَدْرُونَ أيُّهُم أقربُ لكُمْ نفعًا} [سورة النساء/11] وذكر القول الثالث، ونقل عن القرطبي أن كثيرًا من الأحاديث يدل على هذا القول، ونقل عنه أيضًا أنه قال: ويحتمل أن يكون قوله: {إلا ما سعى} [سورة النجم/39] خاصة بالسيئة لما في الحديث: “وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها له حسنة”.
قال ابن القطان: وكنت بحثت مع الشيخ سراج الدين البلقيني بالخشابية بجامع عمرو بن العاص هل تضعف هذه الحسنة أيضًا قلت: وينبغي أن تضعف لقوله تعالى: {إنَّ اللهَ لا يظلمُ مِثقالَ ذرَّةٍ وإن تَكُ حسنةً يُضاعِفْها ويُؤتِ مِن لدُنْهُ أجرًا عظيمًا} [سورة النساء/40] فقال: نعم وتضعف من جنس ما هم به.
ثم قال: ومن المفسرين من قال المراد بالإنسان أبو جهل أو عقبة بن أبي معيط أو الوليد بن المغيرة، قال: ومنهم من قال الإنسان بسعيه في الخير وحسن صحبته وعشرته اكتسب الاصحاب واسدى لهم الخير وتردد إليهم فصار ثوابه لهم بعد موته من سعيه، وهذا حسن، ومنهم من قال: الإنسان في الآية للحي دون الميت ومنهم من قال: لم ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غيره له وإنما نفى عمله بسعي غيره وبين الأمرين فرق.
ثم قال السيوطي: واستدلوا على الوصول بالقياس على الدعاء والصدقة والصوم والحج والعتق، فإنه لا فرق في نقل الثواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو دعاء أو قراءة، وبالأحاديث الواردة فيه وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلًا بأن المسلمين ما زالوا في كل مصر يجتمعون ويقرءون لموتاهم من غير نكير فكان ذلك إجماعًا، ذكر ذلك كله الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في المسئلة، قال القرطبي: وقد كان الشيخ العز بن عبد السلام يفتي لأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ، فلما توفي رءاه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ أو يُهدى إليه فكيف الأمر؟ قال له: كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن قد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك وأنه يصل إليه ذلك، ثم قال السيوطي: ومن الوارد في قراءة القرءان على القبور ما تقدم من حديث ابن عمر والعلاء بن اللجلاج مرفوعًا كلاهما. وأخرج الخلال في الجامع عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم ميت اختلفوا إلى قبره يقرءون له القرءان. وأخرج أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة رفعه: من دخل المقابر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر ثم قال: إني جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لاهل المقابر المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. وأخرج القاضي أبو بكر بن عبد الباقي الأنصاري في مشيخته عن سلمة بن عبيد قال: قال حماد المكي: خرجت ليلة إلى مقابر مكة فوضعت رأسي على قبر فنمت فرأيت أهل المقابر حلقة حلقة فقلت: قامت الساعة، قالوا: لا، ولكن رجل من إخواننا قرأ قل هو الله أحد وجعل ثوابها لنا فنحن نقتسمه منذ سنة. وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال من حديث أنس: من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من دفن فيها حسنات. وقال القرطبي في حديث: “اقرءوا على موتاكم يس” يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته ويحتمل أن تكون عند قبره، قال السيوطي وبالأول قال الجمهور وبالثاني قال ابن عبد الواحد المقدسي في جزئه الذي تقدم ذكره وبالتعميم في الحالين قال المحب الطبري من متاخري أصحابنا، وقال القرطبي: وقيل إن ثواب القراءة للقارئ وللميت ثواب الاستماع ولذلك تلحقه الرحمة، ولا يبعد في كرم الله أن يلحقه ثواب القراءة والاستماع معًا ويلحقه ثواب ما يهدى إليه من القرءان وإن لم يسمع كالصدقة والدعاء اهـ.
تنبيه: سئل ابن القطان: هل يكفي ثواب أو يتعين مثل ثواب. فأجاب في الرسالة المذكورة ما لفظه: ولا يشترط في وصول الثواب لفظ هذا ولا جعل ثواب، بل تكفي النية قبل القراءة وبعدها خلافًا لما نقلناه عن عبد الكريم الشالوسي في القبيلة، نعم لو فعله لنفسه ثم نوى جعله للغير لم ينتفع الغير، ويكفي للقارئ ذكر ثواب ولا يتعين مثل ثواب.
وقال النووي: المختار أن يدعو بالجعل فيقول: الله اجعل ثوابها واقعًا لفلان، وقال في الأذكار: الاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان، وليس ثواب على تقدير المثل بل لو قال: مثل ثواب تكون مثل زائدة كما هو أحد الأقوال في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [سورة الشورى/11]. نعم إن قيل للقارئ ثواب قراءته وللمقروء له مثل ثوابها فيكون ثوابها على تقدير وهو خلاف ظاهر مختار النووي وخلاف الائمة المهدين، فإنهم حين يهدون يقولون: اجعل ثواب، والأصل عدم التقدير، وينقدح في قوله: اجعل ثواب احتمالان: أن يكون للمهدى له وللقارئ مثلها، والثاني: أن يكون للمهدي وهو القارئ والمهدى له مثلها اهـ كلام مرتضى الزبيدي.
ولنختم هذا البحث بما قاله الشطي الحنبلي في تعليقه على غاية المنتهى قال ما نصه [70]: قال في الفروع وتصحيحه: لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة، نص عليه، وهو المذهب فقيل تباح وقيل تستحب. وكذا في الإقناع اهـ.
* والعجب العجاب أن الوهابية يمنعون من هذه التعاويذ التي ليس فيها إلا شيء من القرءان أو ذكر الله ويقطعونها من أعناق من يحملها، فبماذا يحكمون على عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة الذين كانوا يعلقون هذه على أعناق أطفالهم الذين لم يبلغوا، أيحكمون عليهم بالشرك، وماذا يقولون في أحمد بن حنبل الذي سمح بها، وماذا يقولون في الإمام المجتهد ابن المنذر. كفاهم خزيًا أن يعتبروا ما كان عليه السلف شركًا.
روى ابن حجر في الامالي عن محمد بن يحيى بن حبان –بفتح المهملة وتشديد الموحدة- وهو الأنصاري أن خالد بن الوليد كان يأرق من الليل، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم فأمره أن يتعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا مرسل صحيح الإسناد أخرجه ابن السني.
وروى عن محمد بن يحيى بن حبان أن الوليد بن الوليد بن المغيرة شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم حديث نفس يجده فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة فذكره سواء وزاد في ءاخره: فوالذي نفسي بيده لا يضرك شيء حتى تصبح، وهذا مرسل صحيح الإسناد أخرجه البغوي.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع وفي رواية إسماعيل: إذا فزع أحدكم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من بنيه أن يقولها عند نومه ومن لم يبلغ كتبها ثم علقها في عنقه. هذا حديث حسن أخرجه الترمذي عن علي بن حُجر عن إسماعيل بن عباس، وأخرجه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يزيد بن هارون اهـ.
وأما حديث الترمذي: “إن الرُّقى والتمائم والتِوَلة شرك” فليس معناه التمائم والتعاويذ التي فيها قرءان أو ذكر الله لكن الوهابية حرّفت الحديث، والتمائم معروف معناه في اللغة وهي الخرز كانت الجاهلية تضعها على أعناق الغلمان، كما أن الرقى التي قال الرسول إنها شرك هي رُقى الجاهلية وما كان في معناها، وليس المراد بها الرقى التي فعلها الرسول وغيره من الصحابة. انظروا أيها المسلمون كيف يحرفون الكلم عن مواضعه.
وفي كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني [71] ما نصه: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال رأيت على ابن لأحمد وهو صغير تميمة [72] في رقبته من أديم. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يكتب القرءان في شيء ثم يغسله ويشربه؟ قال أرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو داود سمعت أحمد قيل له يكتبه في شيء ثم يغسله فيغتسل به قال: لم أسمع فيه بشيء.
وفي كتاب معرفة العلل وأحكام الرجال [73] عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن فراس عن الشعبي قال: لا بأس بالتعويذ من القرءان يعلق على الإنسان.
وقال عبد الله بن أحمد [74]: رأيت أبي يكتب التعاويذ للذي يفزع، وللحمى لأهله وقراباته، ويكتب للمرأة إذا عسر عليها الولادة في جام أو شيء نظيف، ويكتب حديث ابن عباس، إلا أنه كان يفعل ذلك عند وقوع البلاء، ولم أره يفعل هذا قبل وقوع البلاء، ورأيته يعوّذ في الماء ويُشربه المريض، ويصب على رأسه منه، ورأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه يقبلها، وأحسب أني قد رأيته يضعها على رأسه أو عينه، فغمسها في الماء ثم شربه يستشفي به، ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إليه أبو يعقوب بن سليمان بن جعفر فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته غير مرة يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه اهـ.
وفي مصنف ابن أبي شيبة ما نصه [75]: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولدها، فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صفحة ثم تغسل فتسقى منها: “بسم الله لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، {كأنَّهُم يومَ يرَوْنها لم يلبَثوا إلا عشيةً أو ضُحاها} [سورة النازعات/46]، {كأنَّهُم يومَ يرونَ ما يُوعَدونَ لم يلبثوا إلا ساعةً مِن نهار بلاغٌ} [سورة الأحقاف/35] {فهلْ يُهلَكُ إلا القومُ الفاسِقون} [سورة الأحقاف/35] اهـ.
وفي كتاب الآداب الشرعية [76] لشمس الدين بن مفلح الحنبلي: قال المروزي: شكت امرأة إلى أبي عبد الله أنها مستوحشة في بيت وحدها فكتب لها رقعة بخطه بسم الله وفاتحة الكتاب والمعوذتين وءاية الكرسي وقال كتب إليّ أبو عبد الله من الحمى: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله ومحمد رسول الله {يا نارُ كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم} [سورة الأنبياء/61] اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك إله الحق ءامين وقال: وقال صالح ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحًا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه، قال عبد الله ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم فيستشفي به ويمسح به يديه ووجهه وقال يوسف بن موسى: إن أبا عبد الله كان يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ. قال أحمد يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولدها في جام أبيض أو شيء نظيف بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين {كأنَّهُم يوم يرونَ ما يُوعدونَ لم يلبثوا إلا ساعةً من نهار بلاغٌ} [سورة الأحقاف/35] {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيّةً أو ضُحاها} [سورة النازعات/46] ثم تسقى منه وينضح ما بقي على صدرها، وروى أحمد هذا الكلام عن ابن عباس ورفعه ابن السني في عمل يوم وليلة اهـ.
ولنذكر أخيرًا ما قاله الحافظ المؤرخ ابن طولون من التبرك بأسماء أهل الكهف في كتابه ذخائر القصر [77] في ترجمة محمد بن إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن مفلح الراميني الاصل الصالحي الدمشقي الحنبلي ما نصه: وانشدته ما وجدته بخط العلامة شهاب الدين بن حجي الدمشقي ما أخبرنا به عنه أبو الفتح محمد بن محمد المزي قال: أخبرنا قاضي القضاة جمال الدين أبو اليمن محمد بن أبي بكر المراغي المدني بمنزله بها يوم الأحد الثامن والعشرين من صفر سنة ثمانمائة وخمسة وخمسة عشر في أسماء أصحاب الكهف وأجاز لي روايته عنه وجميع ما يجوز له روايته [شعر]:
يا مَن يرومُ عدّ أهل الكهف *** هم سبعةٌ إحفظ بغيرِ خُلفِ
وإنما الخلفُ جرى في التسمية *** فخذ على المشهور منها نظميهْ
مُكَسلَمين تلوه أمليخا *** ومَرَطُونِس شاع كُنْ مُصيخا
وبعده يا صاح يَنْيُونِسْ رُقِم *** وشازَمُونِسْ فاضبطنه واستقم
وبعده دوانَوانِسْ فاستمع *** كذاك كَشْفِيطط يليه فاتبع
وكلبهم شاع اسمه قِطميرُ *** ثامنهم هذا هو المشهور
فأول الاسماء إن كتبته *** بخرقة ثم إذا نبَذته
وسط الحريق أخمدت نيرانه *** في القوت قد قالوا أتى برهانه
والثاني إن كتبته وألقي *** في البحر يسكن هيجه بصدقِ
وإن يعلق ثالث الاسماء *** بفخذ المسافر المشاء
لم يعي ما دام عليه أبدا *** ولو سعى بالأرض في طول المدا
ويكتب الرابع أيضًا يجعل *** في المال للحفظ كما قد نقلوا
وعلق الخامس بعد كتبه *** على الذي يحم وانفعه به
يا صاح واجعل سادس الأسماء *** حرزًا على ذي الجيش في الهيجاء
والسابع اكتبنه في الإناء *** علقه واسقه للاصطفاء
وقال بعض العلماء نفعها *** لستة أشياء جل وقعها
فعد منها طلبًا وهربًا *** وللحريق مثل ما قد كتبا
ولبكاء الطفل أيضًا ترقم *** في المهد تحت رأسه وترسم
كذا صداع ضرَبانٌ حُمَّى *** فاحفظ هديت ضبط هذا نظما
ومن بدع الوهابية التي سنّها لهم محمد بن عبد الوهاب تحريم الصلاة على النبي جهرًا من المؤذن عقب الأذان، وهم يبالغون في ذلك حتى قال أحدهم في الشام في جامع الدقاق حين سمع المؤذن يقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله: هذا حرام هذا كالذي ينكح أمه، وذلك منذ نحو أربعين سنة وشيء وهم شديدو الولوع بذلك كأنهم على زعمهم ينكرون كفرًا بل الغالب على الظن أنهم يعتبرونه كفرًا. لأنه حصل من زعيمهم محمد بن عبد الوهاب أنه سيق إليه رجل مؤذن أعمى فقيل له: هذا صلى على النبي جهرًا عقب الاذان فأمر بقتله فقُتل.
نقول بعون الله: ثبت حديثان أحدهما حديث مسلم: “إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليّ”. وحديث: “من ذكرني فليصلّ عليَّ” أخرجه الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على النبي الشفيع وقال لا بأس بإسناده، فيؤخذ من ذلك أن المؤذن والمستمع كلاهما مطلوب منه الصلاة على النبي، وهذا يحصل بالسر والجهر. فإن قال قائل لم ينقل عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم جهروا بالصلاة عليه، قلنا: لم يقل النبي لا تصلوا علي إلا سرًا، وليس كل ما لم يفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حرامًا أو مكروهًا، إنما الأمر في ذلك يتوقف على ورود نهي بنص أو استنباط من مجتهد من المجتهدين كمالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم ممن جاء بعدهم من المجتهدين الذين هم مستوفو الشروط كالحافظ ابن المنذر وابن جرير ممن لهم القياس أي قياس ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه نص، والجهر بالصلاة على النبي عقب الأذان توارد عليه المسلمون منذ قرون فاعتبره العلماء من محدثين وفقهاء بدعة مستحبة منهم الحافظ السخاوي قال في القول البديع [78]: أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للفرائض الخمس إلا الصبح والجمعة فإنهم يقدمون ذلك فيها على الأذان وإلا المغرب فإنهم لا يفعلونه أصلًا لضيق وقتها، وكان ابتداء حدوث ذلك من أيام السلطان الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب وأمره، وقد اختلف في ذلك هل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروع واستدل للأول بقوله تعالى: {وافعلوا الخيرَ} [سورة الحج/77] ومعلوم أن الصلاة والسلام من أجل القرب لا سيما وقد تواردت الاخبار على الحث على ذلك مع ما جاء في فضل الدعاء عقب الاذان والثلث الاخير من الليل وقرب الفجر والصواب أنه بدعة حسنة يؤجر فاعله بحسن نيته. انتهى. ونقل ذلك عنه صاحب مواهب الجليل الحطاب المالكي ووافقه [79].
قال السيوطي في كتابه الوسائل في مسامرة الأوائل [80] أول ما زيد الصلاة والسلام بعد كل أذان في المنارة في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنبدي وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، وكان حدث قبل ذلك أيام السلطان صلاح الدين بن أيوب أن يقال في كل ليلة قبل أذان الفجر بمصر والشام “السلام على رسول الله”، واستمر ذلك إلى سنة سبع وستين وسبعمائة فزيد بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال: “الصلاة والسلام عليك يا رسول الله” ثم جعل في عقب كل أذان سنة إحدى وتسعين اهـ.
* وكذلك ابتدعوا تحريمهم للمولد أشد التحريم حتى قال أحد دعاتهم البارزين اليوم وهو أبو بكر الجزائري: إن الذبيحة التي تذبح لإطعام الناس في المولد أحرم من الخنزير.
وعمل المولد الذي جرى عليه عمل المسلمين منذ مئات من السنين لم يحرمه ابن تيمية بل ذكر في بعض فتاويه أنه إن عمل بنية حسنة يكون فيه أجر، فهو إجماع فعلي توارد عليه الملوك والمشايخ بما فيهم من حفاظ الحديث والفقهاء والزهاد والعباد والافراد من العوام، وله أصل يرجع إليه بطريق الاستنباط كما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، فإذا ظهر هذا فمع من تكون هذه الفئة الشاذة الوهابية لا هي مع أهل السنة ولا هي مع زعيمها ابن تيمية فليرجعوا إلى أنفسهم باللوم وليرجعوا عن غيّهم. أقول تشنيعهم هذا على عمل المولد يشبه تشنيع بعضهم لعمل المحاريب في المساجد فقد حصل من وهابية الجزائر أنهم سدوا محاريب المساجد بالأخشاب، فكفاهم خزيًا أن يستقبحوا أمرًا اتفق عليه المسلمون منذ ثلاثة عشر قرنًا.
وأما ابن تيمية فقد قال في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم [81] ما نصه: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له. والله قد يثبتهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع، ثم قال: فتعظيم المولد واتخاذه موسمًا قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم، كما قدمته لك اهـ.
الهوامش:
[1] انظر شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص/160.
[2] انظر حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح ص/489.
[3] أي بالجارحة والجزء.
[4] وقد مرّ ما قاله الصفدي فيه من تشبيهه له في اللغة بالجوهري والأزهري اللذين هما أشهر أئمة اللغة.
[5] الخدر مرض شبه التشنج وليس ما يُسمى عند العامة التنميل.
[6] أي حُلَّ عنه الحبل الذي يقيد به الإبل ونحوه.
[7] انظر الكتاب ص/156.
[8] انظر الكتاب ص/158.
[9] لا معنى للتردد الذي في ضمن كلام القاري لأنّ أحدًا من المسلمين خواصهم وعوامهم لا يشكُ في كون زيارة قبر الرسول في السفر وفي غير السفر قربة إلى الله، فالصواب الجزم.
[10] توفي ابن عقيل سنة 503هـ. وتوفي ابن تيمية سنة 728هـ.
[11] انظر مجمع الزوائد [8/211]. قال الهيثمي: ورجال أبي يعلى ثقات.
[12] انظر كشف الأستار [3/100].
[13] انظر المعجم الكبير [9/17]، والمعجم الصغير [201].
[14] الإقبال بالوجه من الله تعالى ليس على ظاهره بل يؤول بمعنى الرضا عنه.
[15] أي أن حديث بلال مضمونه أن الرسول كان إذا خرج يقول ذلك فهو حكاية عن فعله عليه السلام أي عن خروجه إلى المسجد، وأما حديث أبي سعيد فهو إخبار بفضل من يقول هذا الذكر إذا خرج إلى المسجد، وليس فيه نسبة الخروج إلى الرسول، فالأول الذي هو إسناده تالف، وأما الثاني فإسناده حسن كما فهم ذلك من قول الحافظ.
[16] انظر شفاء السقام ص/161.
[17] انظر الكتاب [2/69].
[18] انظر الكتاب [2/456].
[19] انظر الكتاب [10/130].
[20] قال الزبيدي: قد تعقدت ساقاه من طول القيام في الصلاة، وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له القيامة غدًا ما وجد متزايدًا، رواه أبو نعيم في الحلية فقال حدثنا الحسن بن علي الوراق حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محمد بن يزيد الآدمي حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غدًا القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. وكان إذا جاء الشتاء اضطجع على السطح ليضربه البرد وإذا كان في الصيف اضطجع داخل البيوت ليجد الحر والغمّ فلا ينام. رواه أبو نعيم في الحلية فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا جعفر الفريابي حدثنا أمية حدثنا يعقول بن محمد حدثنا سليمان بن سالم قال: كان صفوان بن سليم في الصيف يصلي بالليل في البيت فإذا كان في الستاء صلى في السطح لئلا ينام، حدثنا أبو محمد بن حيان حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا إسحاق بن محمد الفردي حدثنا مالك بن أنس قال كان صفوان بن سليم يصلي في الشتاء في السطح وفي الصيف في بطن البيت يستيقظ بالحر والبرد حتى يصبح ثم يقول: هذا الجهد من صفوان وأنت أعلم به، وإنه لَتَرِم رجلاه حتى يعود مثل السقط من قيام الليل وتظهر فيها عروق خضر وإنه مات وهو ساجد، رواه أبو نعيم في الحلية فقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن أحمد بن أيوب المقري حدثنا أبو بكر بن صدقة حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول وأعانه على بعض الحديث أخوه محمد قال أبى صفوان بن سليم أن لا يضع جنبه على الأرض حتى يلقى الله عز وجل، فلما حضره الموت وهو منتصب قالت له ابنته: يا أبت في هذه الحالة لو ألقيت نفسك قال: إذًا يا بنية ما وفيت له بالقول، وزاد المزي في التهذيب من طريق سفيان أنه مكث على ذلك أكثر من ثلاثيت سنة ومن طريق غيره أربعين سنة قال فلما حضرته الوفاة واشتد به النزع والعجز قالت ابنته: يا أبت لو وضعت حنبك فقال: يا بنية إذًا ما وفيت لله عز وجل بالنذر والحلف فمات وإنه لجالس، قال سفيان فأخبرني الحفار الذي يحفر قبور أهل المدينة قال: حفرت قبر رجل فإذا أنات قد وقعت على قبر فوافيت جمجمة فإذا السجود قد أثر في عظام الجمجمة، فقلت لإنسان: قبر من هذا؟ فقال: أوما تدري، هذا قبر صفوان بن سليم، وكان يقول في دعائه: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي ينزع بذلك إلى ما ورد في الخبر: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه اهـ.
[21] انظر طبقات الحفاظ ص/61.
[22] انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين [1/254].
[23] انظر كشف الأستار [1/397] وقال في المجمع [9/24] ورجاله رجال الصحيح.
[24] وهي التي تسمى بالعامية خيمة.
[25] انظر إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين [10/368].
[26] انظر الكتاب [2/135].
[27] انظر البداية والنهاية لابن كثير [7/91].
[28] انظر فتح الباري [2/495].
[29] انظر البداية والنهاية لابن كثير [7/90].
[30] أي تجول في البلد ليلًا ليفتش أحوال البلد.
[31] الذي عليه الحزَن.
[32] معناه كيتَ وكيت.
[33] انظر كشاف القناع [2/68].
[34] انظر الكتاب [2/35].
[35] انظر كشاف القناع [2/150].
[36] انظر الكتاب ص/259.
[37] انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف [2/562].
[38] انظر الكتاب المجلد الثاني [4/1405].
[39] انظر المجلد الخامس [9/241].
[40] وهذا استفهام إنكاري أي أيقوله؟.
[41] انظر الكتاب [3/450].
[42] قطعة من المنبر مدورة على شكل رمانة وكان رمانتان على جانبي المنبر.
[43] أي الملساء.
[44] انظر الكتاب ص/367.
[45] انظر الكتاب [11/212].
[46] انظر الكتاب [10/333].
[47] انظر الكتاب [10/334].
[48] انظر كشف الأستار [1/395] وقال في المجمع [3/48] ورجاله موثقون.
[49] انظر الإتحاف [10/321].
[50] انظر صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة.
[51] انظر اتحاف السادة [4/429].
[52] انظر فتح الباري [1/569].
[53] انظر الكتاب ص/129.
[54] انظر اتحاف السادة [4/416].
[55] انظر دفع الشبه/114-115.
[56] أي عاجزة عن السفر إلى مقصدها.
[57] أي إلى جهة.
[58] جمع الحرث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله وذلك لأن الله هو المستعاذ الحقيقي، وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب.
[59] انظر المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني [3/273].
[60] في شرح القاموس [2/192] ما نصه: طلحةُ الطلحاتِ “في بعض حواشي نسخ الصحاح بخط من يوثق به الصواب طلحة بن عبد الله قال ابن بري ذكر ابن الأعرابي في طلحة الطلحات لأن أمه صفية بنت الحارث بن أبي طلحة زاد الأزهري: بن عبد مناف قال: وأخوها أيضًا طلحة بن الحارث فقد تكنفه هؤلاء الطلحات كما ترى ومثله في شرح أبيات الإيضاح وفي تارخ ولاة راسان لأبي الحسين علي بن أحمد السلامي سمي به لأنه أمه طلحة بنت أبي طلحة وفي الرياض النضرة أن أمه صفية بنت عبد الله بن عباد بن مالك بن ربيعة الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي أسلمت وقال ابن الأثير ثيل أنه جمع بين مائة عربي وعربية بالمهر والعطاء الواسعين فولد لكل منهم ولد فسمى طلحة فأضيف إليهم وفي شواهد الرضى لأنه فاق في الجود خمسة أجواد اسم كل واحد منهم طلحة وهم طلحة الفياض، وطلحة الجود، وطلحة الدراهم، وطلحة الندى، وقيل كان في أجداده جماعة اسم كلٌ طلحة كذا في شرح المفصل لابن الحاجب وفي كتاب الغرر لإبراهيم الوطواط الطلحات خمسة وهم طلحة بن عبيد الله التيمي وهو طلحة الفياض وطلحة بن عمر بن عبد الله بن معمر التيمي وهو طلحة الجود وطلحة بن عبد الله بن عوف الزهري ابن أخي عبد الرحمن بن عوف وهو طلحة الندى وطلحة بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو طلحة الهير وطلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر ويسمى طلحة الدراهم وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي وهو سادسهم المشهور بطلحة الطلحات ومثله كلام ابن بري وقبر طلحة الندى بالمدينة وقبر طلحة الطلحات بسجستان وفيه يقول ابن قيس الرقيات:
رحم الله أعظمًا دفنوها *** بسجستان طلحة الطلحات
[61] أي واحد من الأشراف من ذرية علي.
[62] الزنبيل هو وعاء من قصب يوضع فيه الخضرة. [وهو السلة].
[63] انظر تاريخ بغداد [1/120].
[64] الوشل: بفتح الواو والشين الماء القليل يتحلّب من جبل أو صخرة ولا يتصل قطره، ويطلق على القليل من الدمع.
[65] انظر المعيار [2/82].
[66] أخرجه أحمد في مسنده [6/7].
[67] رواه البيهقي في السنن [4/70].
[68] انظر الكتاب [1/253].
[69] انظر الكتاب [10/369].
[70] كتبه أبو بكر، والمروذي نسبة إلى مرو الروذ مدينة بخراسان بينها وبين مرو الشاهجان خمس مراحل.
[71] انظر الكتاب ص/260.
[72] انظر الكتاب ص/260.
[73] أي حرزًا لا يعني التميمة التي هي خرزات التي ثبت النهي عنها بقوله عليه السلام: “إن الرقى والتمائم والتولة شرك”. فلا تغفل أيها الناظر. وتلك التمائم التي نهى الرسول عنها لأنها كانت الجاهلية يعلقونها على أعناقهم يعتقدون أنها بطبعها تحفظ من العين ونحوها من دون اعتقاد أنها تنفع بإذن الله ولهذا الاعتقاد سماها الرسول شركًا كما أنه ذكر الرقى في هذا الحديث لأن الرقى منها ما هي شركية ومنها ما هي شرعية فرقى الجاهلية التي جعلها الرسول شركًا كان فيها دعوة الشياطين والطواغيت ومعلوم أن كل قبيلة من العرب كان لها طاغوت وهو شيطان ينزل على رجل منهم فيتكلم على لسانه فكانوا يعبدونه. وأما الرقى الشرعية فقد فعلها الرسول وعلمها أصحابه وأما التمائم فإن المسلمين من عهد الصحابة كانوا يستعملونها للحفظ من العين ونحوها بتعليقها وتتضمن شيئًا من القرءان أو ذكر الله فانظروا أيها المسلمون كيف حرفت الوهابية الكلم عن مواضعه.
[74] انظر الكتاب ص/278-279.
[75] انظر كتاب مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص/447.
[76] انظر الكتاب [7/385].
[77] انظر الآداب الشرعية [2/476]. وشمس الدين بن مفلح كان أعرف الناس بمسائل ابن تيمية التي انفرد بها، توفي سنة 763هـ.
[78] انظر ذخائر القصر ص/97 [مخطوط].
[79] انظر الكتاب ص/192.
[80] انظر مواهب الجليل [1/430].
[81] انظر الكتاب ص/14.
[82] انظر اقتضاء الصراط لابن تيمية ص/294 و297.
- كتب الشيخ جيل صادق
- كتب للتحميل
- بغية الطالب
- نُور العُيون في تلخيص سيرة الأمِين الـمَأمُونِ
- جامع الخيرات – الجزء الرابع
- الجزء الأول – الفرقان في تصحيح ما حُرّفَ تفسيره من ءايات القرءان
- الجزء الثاني – الفرقان في تصحيح ما حُرّفَ تفسيره من ءايات القرءان
- البحوث الحسان من صريح البيان في الرد على من خالف القرءان
- مقصد الراغبيـن فـى تعلم العقيدة وأحكام الدين
- أنس المجالس- الجزء الأول
- مختصر المطالب الوفية
- بهجة النظر
- عمدة الراغب
- الجزء الأول – قبسات نورانية على ألفية السيرة النبوية
- الجزء الثاني – قبسات نورانية على ألفية السيرة النبوية
- أنس الذاكرين
- الأَدَبُ الـمُفرد
- الأربعون الهررية
- المزيد+